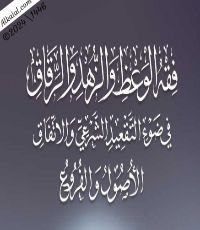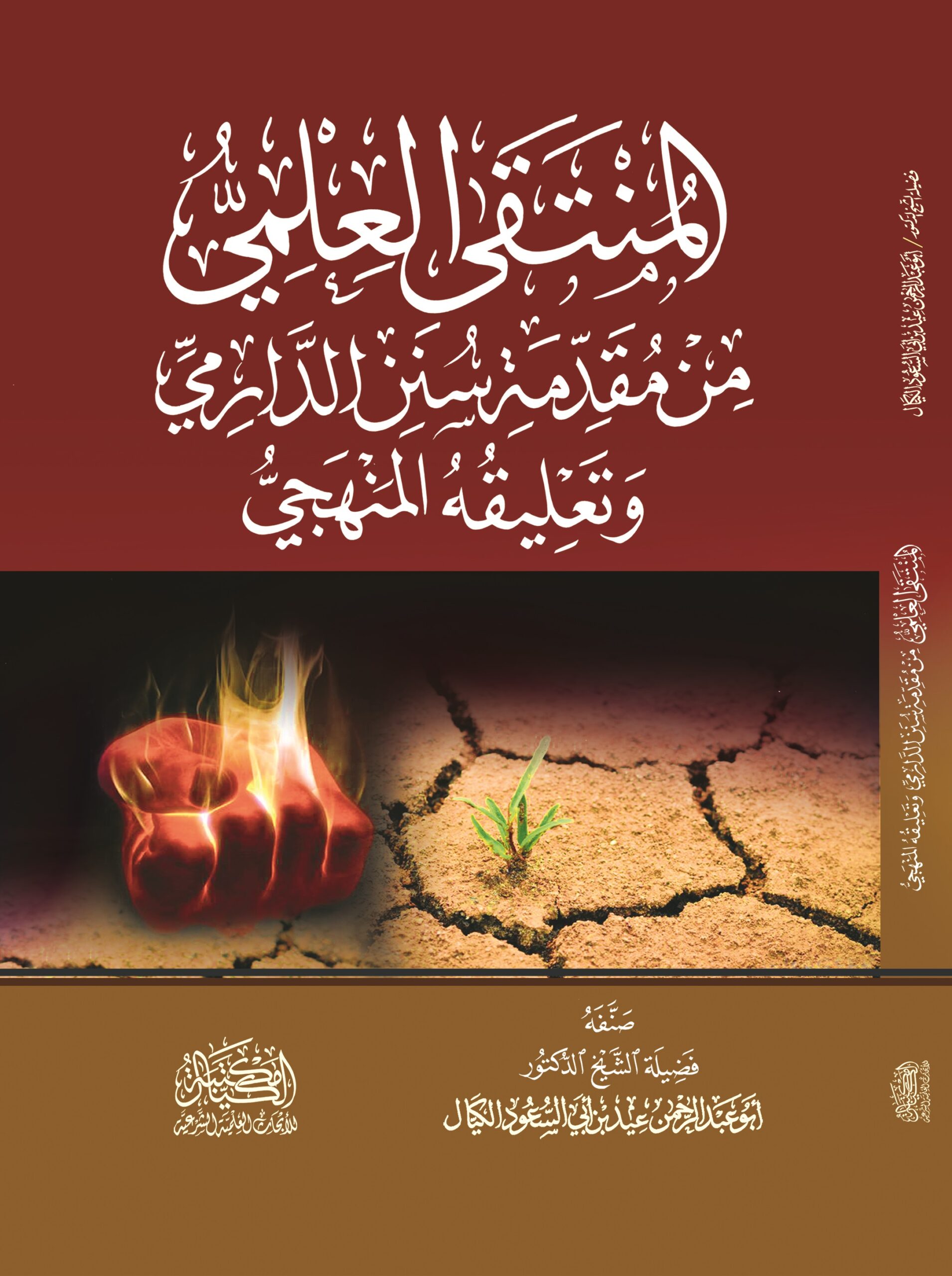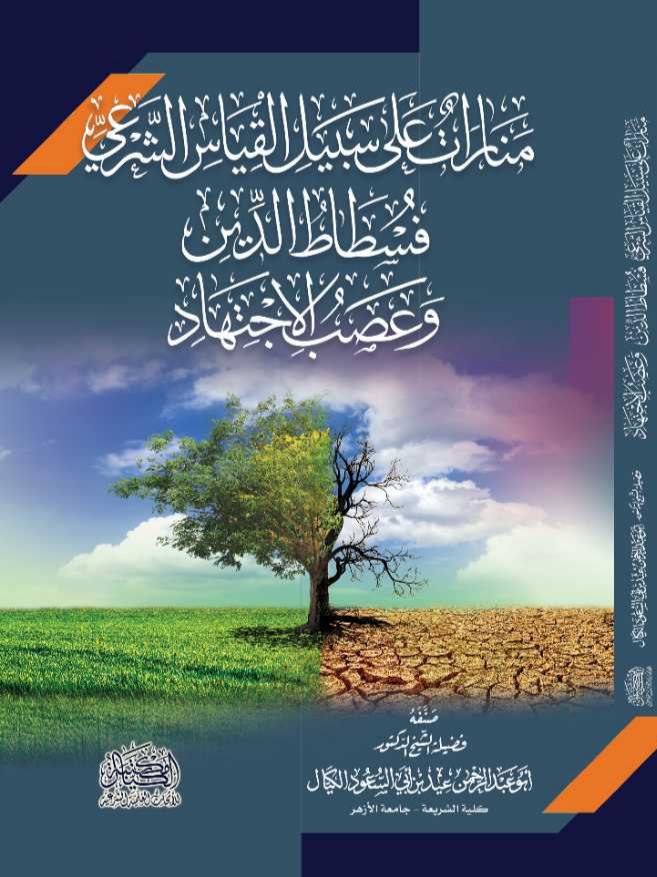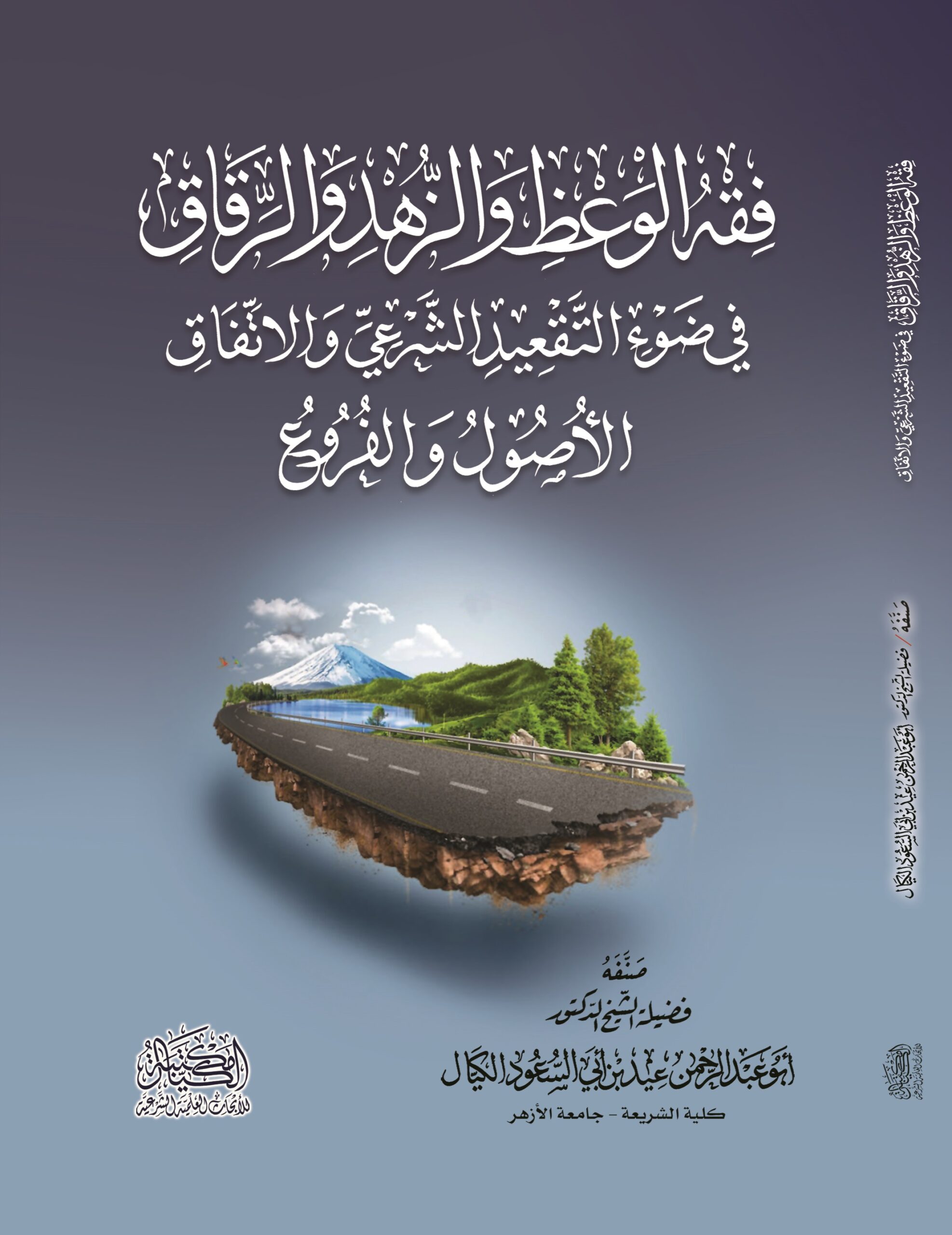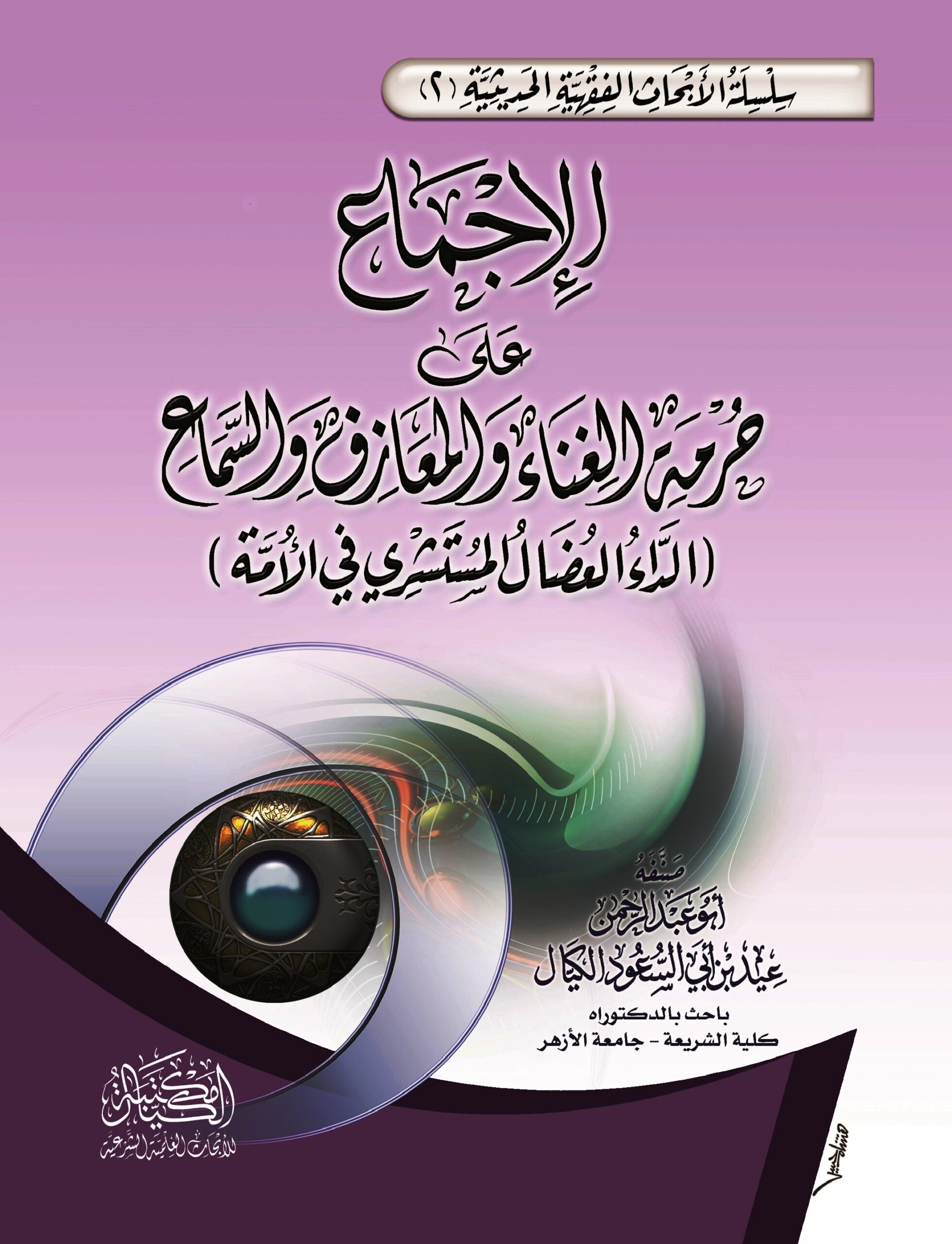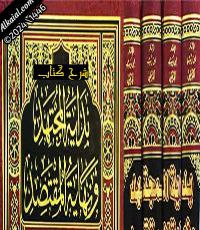«¢»
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ﷺ أمَّا بعد:
فمن أهم مواضيع علم أصول الفقه: الأدلة الشرعية، التي تُبنى عليها الأحكام التكليفية، والتي قامت كلها على الأصلِ الكُلِّي: كتابِ الله، ثم سنةِ رسول الله ﷺ وهما أصلا كلِّ الأدلةِ المتفرعة عليهما، ثم الإجماعِ الأصلِ الثالثِ، وهو قائمٌ على الكتاب والسنة، ثم القياسِ الذي هو الرابعُ وعامتُه على القرآنِ والسنةِ والإجماع، حيث يجوز أن يكون أصل القياس الإجماع، وهو حجة قطعية لاسيما الإجماع القولي.
ثم من بعدهم الاستصحاب، والعُرف، وسد الذرائع، والمصلحة المرسلة، وهذه الأصول الأربعة حجة معتبرة عند التحقيق، مع أن غالب الأصوليين يعتبرونها من الأدلة الشرعية المختلف فيها، بعد الإجماع على الأصول الأربعة المتقدمة.
وإنه بالتتبُّع والاستقراء: أن الأربعة الأُخَرَ عليهم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، كما حققتُهم في أكثر من كتاب، ككتابي: «مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه»، وكتابي: «الفِلذ شرح النبذ في أصول الفقه»، وكتابي: «ما قلَّ ودلَّ في أصول الفقه للمستدل»، وقد فصَّلْت الكلام عليهم، وكذلك شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، والراجحُ اعتباره دليلًا شرعيًّا.
ثم إنه قد تكلم الأصوليون على دليلٍ مختلَفٍ عليه، وهو: «الاستحسان»، وأنكرهُ الجمهور، وارتضاه الحنفية، وحكى ابن حزم في «الإحكام» إنكار الطحاوي الحنفي له، واعتبره الإمام مالك، فدار السِّجال بينهم، بين المخالف والمؤيِّد، وهذه كلمات مختصرة تُبَيِّن في هذه المقالة تصوُّرَ هذه المسألة.
* تصوُّر المسألة:
قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعة حقًّا: «البحر المحيط في أصول الفقه» (6/87، وما بعدها):
«الاستحسان: وقد نُوزع في ذكره في جُمْلَة الأدلة بأنَّ الاستحسان العقلي لا مجال له في الشرع، والاستحسانُ الشرعي لا يخرُجُ عما ذكرناه، فما وجهُ ذِكْرِهِ؟!
وهو لغةً: اعتمادُ الشيء حَسَنًا، سواءً كان عِلْمًا أو جهلًا، ولهذا قال الشافعي: القول بالاستحسان باطل؛ فإنه لا يُنَبِّئُ عن انْتحالِ مذهبٍ بحجةٍ شرعيةٍ، وما اقتضته الحجةُ الشرعيةُ هو الدين، سواءً استحسنه نَفْسَهُ أم لا.
ونُسِب القول به إلى أبي حنيفة، وعن أصحابه أنه أحد القياسَيْن، وقد حكاه عنه الشافعي، وقال الماوردي: وأنكر أصحابه ما حكى الشافعي عنه، ونَسَبَهُ إمام الحرمين إلى مالك، وأنكره القرطبي وقال: ليس معروفًا من مذهبه.
وقد أنكره الجمهور حتى قال الشافعي: «من استحسن فقد شرَّع»، وهي من محاسن كلامه، وقال الرُّوياني: ومعناه أن يُنَصِّب من جهة نفسه شرعًا غير شرع المصطفى ﷺ.
قال السنْجي في: «شرح التلخيص»: مراده لو جاز الاستحسان بالرأي على خلاف الدليل؛ لكان هذا بَعْثَ شريعةٍ أخرى على خلاف ما أمر اللَّه، والدليل عليه: أن أكثر الشريعة مبني على خلاف العادات، وعلى أن النفوس لا تميل إليها، ولهذا قال ڠ: «حُفَّت الجنةُ بالمَكاره، وحُفَّت النارُ بالشهوات» [رواه مسلم (2822)]، وحينئذٍ فلا يجوز استحسان ما في العادات على خلاف الدليل.
وقال الشافعي في: «الرسالة»: الاستحسان تلذُّذ، ولو جاز لأحدٍ الاستحسان في الدين، جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يُشرَّع في الدين في كل باب، وأن يُخَرِّج كل واحدٍ لنفسه شرعًا، وأيُّ استحسان في سفك دمِ امرئ مسلم؟!
وقال الشافعي في آخر «الرسالة»: «تلذذ»؛ وإنما قال ذلك لأنه قد اشتُهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما يقع في خاطره من غير دليل.
وقال ابن القطان: قد كان أهل العراق على طريقةٍ في القول بالاستحسان، وهو ما استحسنته عقولهم وإن لم يكن على أصل، فقالوا به في كثير من مسائلهم [يعني: الحنفية].
* واعلم أنه إذا حُرِّر المراد بالاستحسان زال التشنيع، وأبو حنيفة برئ إلى الله من إثبات حكم بلا حجة [قلت: وهذا حقٌّ وهو مِنَ الإنصاف].
وقال الباجي: ذكر محمد بن خويز مِنْدَادِ المالكي: معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك: هو القول بأقوى الدليلين، كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر [رواه البخاري (2191)، ومسلم (1540)، وبيع العرايا: هو بيع الرطب في رؤوس النخل تقديرًا وخَرْصًا بالتمر على وجه الأرض وهو رِبًا]، قال: فإذا وردت السنة في الرخصة في بعض المواضِع صِرْنَا إليه، وأبقينا الباقي على الأصل [قُلت: وهذه قاعدة أصولية معتبرة مطردة مستمرة، فيجب الأخذ بها لهذا الحديث وأمثالِه في الرُّخص عامة] قال:
وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، فإن سمَّاه استحسانًا فلا مشاحة في التسمية.
وقال بعض محقِّقي المالكية: بَحَثْتُ عن موارد الاستحسان في مذهبنا فإذا هو يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضى الدليل، كترك الدليل للعُرف في رَدِّ الأَيْمان إلى العُرف أو المصلحة، كما في تضمين الأجير المتشرك، ولإجماع أهل المدينة في اليَسير مِنْ رَفْعِ المشقة وإيثار التوسعة، وهو معنى في سلوكه إبطالُ القواعِدِ، ولا يجري عليها جَرْيًا مخْلصًا، كما في مسألة خيار الرؤية.
وقال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به.
ثم نبَّه ابن السمعاني على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، فإن تفسير الاستحسان بما يُشنَّع عليهم لا يقولون به.
والذي يقولون به إنه: العدول عن الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، فهذا مما لم نُنْكِرْه، لكنْ هذا الاسمُ لا نعرفه اسمًا يقال به بمثل هذا الدليل.
وقريب منه ما قاله القفال الشاشي: إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول لمعانيها فهو حسن؛ لقيام الحجة به وتحسين الدلائل، فهذا لا نُنْكِره ونقولُ به، وإن كان ما يَقْبُحُ في الوهم مِنَ استقباح الشيء واستحسانه، بحجّة دلت عليه مِنْ أصلٍ ونظيرٍ فهو محظور، والقول به غير سائغ.
قال السنْجِي: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم وهي على ضربين:
أحدهما: واجب بالإجماع، وهو أن يقدِّم الدليل الشرعي أو العقلي على حُسنه، كالقول بحدوث العَالَم وقِدَم المُحْدِث وبَعْثَة الرسل وإثبات صِدْقِهِم، وكونِ المُعْجزة حُجةً عليهم، ومثل مسائل الفقه، لهذا الضرب يجب تحسينه؛ لأن الحُسْنَ ما استحسنه الشرعُ، والقبحَ ما قبَّحه.
والثاني: أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورًا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، ويكون في الشرع دليل يغلِّظه وفي عادات الناس التخفيف، فهذا عندنا يحرم القول به، ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، وسواء كان ذلك الدليل نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك الدليل إن كان خبر واحد أو قياسًا اسْتُحْسن تركهما والأخذ بالعادات». اهـ
قلت: وهذا باطل من أبي حنيفة، فإن كان القياس صحيحًا معتبرًا بأركانه من مساواة الفرع للأصل في العلة الجامعة بينهما ورجوع العلة إلى دليل صحيح، فقد صح القياس واستقام الحكم.
وأما خبر الواحد فقد نقل أكثر أهل العلم الإجماع عليه، فقد نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (2/115-116) قال:
«العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي ﷺ وفي توجيهاته وُلاتِهِ ورسلِه آحادًا للآفاق، لِيُعَلِّموا الناس دينهم فيُبلِّغُونهم سُنة رسولهم ﷺ من الأوامر والنواهي». اهـ
وذلك عند الآية من سورة البقرة (142).
ونقله ابن حجر في «فتح الباري» (10/219) عند حديث البخاري (5729)، وكذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (1/11)، وابن حزم والسمعاني وغيرهم، وقد فصلته في كتابي «ما قلَّ ودل» (1/365 وما بعدها)، وفي «الفِلذ شرح النُّبذ».
* ذِكرُ ما نص عليه الإمام الشافعي في الاستحسان:
فقال الشافعي في «الرسالة» [(ص494 وما بعدها) تحقيق الشيخِ أحمد شاكر]، وهو يحاور رجلًا في الاستحسان فقال له الرجل:
«قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلّا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدًا إلى على عين ائمة تُطلب بدلالة يُقصد بها إليها، أو تشبيهٍ على عين قائمة، وهذا يُبيّن أنَّ حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ من الكتاب والسنة عينٌ يتأخَّى [تعني: يقصد ويتحرَّى] معناها المجتهد ليصيبَه كما البيت يتأخَّاه من غاب عنه ليصيبَه، أو قصَدَه بالقياس، وأن ليس لأحدٍ أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تُجِيز أنت أن يقول الرجل: استحسن بغير قياس؟ [قال الشافعي:]
فقلت: لا يجوز هذا عندي لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم؛ لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس في الخبر بالقياس على الخبر. ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحْضُرهم من الاستحسان، وإنَّ القول بغير خبر ولا قياس لغَيْرُ جائزٍ بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله ولا في قياس.
فقال: أما الكتاب والسنة فيدلّان على ذلك؛ لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلّا على طلبٍ، وطلبُ الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس، فأين القياس مع الدلائل على وصفت؟
قلت: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجلٌ لرجلٍ [شيئًا لم يقولوا للرجل: أقِمْ شيئًا]، إلا وهو خابِرٌ بالسوق فيما يُخبرُكُم ثمن مثلِه في يومه، ولا يكون إلا بأن يُعْتَبر عليه بغيره فيقيسَه عليه، ولا يقال لصاحب سلعة: أقِم إلا وهو خابر بالقِيَم، ولا يجوز أن يُقال لفقيه عدل غير عالم بقيم [الأشياء]: أقم هذا الشيءَ، ولا إجارةَ هذا العامل؛ لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان مُتعسفًا، فإذا كان هذا هكذا فيما تَقِلُّ قِيمتُهُ ويَيْسُرُ الخطأ فيه على المُقامِ له والمُقام عليه: كان حلالُ الله وحرامُه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسُّف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ، ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار، عاقل للتشبيهِ عليها، وإذا كان هذا هكذا، كان على العالم أن لا يقول إلَّا من جهة العِلمِ -وجهة العلم الخبرُ اللازم- بالقياس، كما يكون متبعُ البيتِ بالعِيان وطالبً قَصْدَه بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا، ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس، كان أقربَ منَ الإِثم الذي قال وهو غيرُ عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزًا.
ولم يجعلِ اللهُ لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله، وجهته العلم بعد الكتاب والسنّة والإجماع والآثار، وما وصفتُ من القياس عليها». اهـ
* بيان خطورة التحسين العقلي:
قلت: وما قاله الإمام الشافعي تحقيق في عدم حجّية الاستحسان وكونِه تشريعًا بالهوى والشهوى، قال الله تعالى: ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [يونس: 59]، وقال سبحانه: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [النحل: 116]، وقال ۵: ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الشورى: 21].
وروى أبو نعيم في «الحلية» (8455) عن عطاء بن أبي رباح قال:
«بلغنا أنّ الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان» نسأل الله السلامة والعافية.
إن الأئمة الأربعة وأهل العلم قاطبة لَيَعْرِفون ويعلمون الفرق بين الاستحسان الجائز، والحرام الذي قام على الباطل والهوى، الذي يهوي بصاحبه إلى جُرُفٍ هارٍ يهوي به في جهنم وإلى الحضيض الأوهد، وهو الاستحسان القائم على التحسين العقلي، والاستحسانات تتغيّر وتتباين وتختلف باختلاف العقول والأفكار وكلٌّ يقولُ بقوله، من غير حدٍّ ولا ضابط، ولا شرط ولا علم، وليس ثَم إلا الهوس والهوى والتشهي والعقول الضالة، وهو منهج المعتزلة المنحرفين عن جادة الطريق الحق.
قال الإمام السمعاني في «قواطع الأدلة» (1/23):
«وهذا الحد هو حدّ المعتزلة وهم ضلال في كل ما ينفردون به». اهـ
وهذا الأصل بالتحسين والتقبيح العقلي، هو أصل من أصول البلاء في دين الإسلام الحنيف السمح السهل اليسير، وقام عليه منهج التضليل عن الكتاب والسنة والإجماع والآثار، إلى اتباع العقول المخالفة للأدلة الشرعية، وفتح باب العقول الفاسدة الباطلة التي أطاحت بالأمة واستحسنها الرجال ودافعوا عنها فهلكوا وأهلكوا؛ لأنهم رفعوا رايات هدم الدين كله، والزيغ والانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، والسخرية بالكتاب والسنة، واعتبار منزلة العقل البشري فوق كلام الله ورسوله، وهذا حال المستشرقين الذي طبعوه في قلوب ملايين المسلمين، ونشروه ودافعوا عنه ونادوا به بما يدعو إلى الخروج من الملة تصريحًا لا تلميحًا، ومَثلهم مَثل من يقول بقولهم من كُتَّاب العرب المشهورين المعروفين، في أنحاء الأمة بأقطارها من قبل ومن بعد، وينادون في الأمة، حتى حدث ما حدث في أرض الله الحرام، ممن ظهر أمرهم -مثلًا- من جملة من الشابَّات اللاتي هربن من بلدهن وأعلنَّ أمام العالم باعتناقهن غير الإسلام وسعادتهن بذلك أمام العالمين، وهذا شر مستطير وبلاء كبير، وليس ثمّ إلا العبث بعقيدة المسلمين ودينهم، والزَّجّ بشباب المسلمين وفتيانهم إلى رحى العلمانية والليبرالية والأفكار الواردة على دين المسلمين، وكل هذا الضلال من الثمار الخلَّاقة لمنهج التحسين العقلي الخالي عن الدليل.
ومن هذا التحسين العقلي الذي يخالف الأدلة الشرعية، تجرَّأ الكثير والملايين من المسلمين على ردِّ صحيحي البخاري ومسلم بالعقل الفاسد وإعمال عقولهم في النصوص الشرعية بديلًا عن السنة الشريفة الصحيحة النبوية الإلهية!!! وتبجَّحَ الملايين على الأحكام الشرعية والتَّسْفِيه لها، وهذا خَطْبٌ جسيم عظيم جلل، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* بيان تعريف الاستحسان لغةً وشرعًا وبيان حقيقته:
قال نجْم الدين الطوفيُّ، في «شرح مختصر الروضة» لابن قدامة: (3/190/وما بعدها):
«من الأصول المختلف فيها الاستحسان: وهو استفعال من الحُسْن، وهو اعتقاد الشيء حسنًا، ولم نقل: العلم بكون الشيء حسنًا؛ لأن الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر؛ إذْ قد يكون الاعتقاد صحيحًا إذا طابق الواقع، وقد يكون فاسدًا إذا لم يطابق، وحينئذٍ قد يستحسن الشخص شيئًا على اعتقاده ولا يكون حسنًا في نفس ا لأمر، وقد يخالفه غيره في استحسانه.
وقد استحسن بعض الناس عبادة الأصنام [كما حدث في مصر من أكثر من عشر سنين بطائفة من المصريين وسمُّوا أنفسهم «عبدة الشيطان» وقد جلستُ مع واحد منهم بعد أن تاب إلى الله وقد أطلق لحيته وكلمني فيما كانوا يفعلون جميعًا بالتفصيل]، وبعضهم عبادة الكواكب، وبعضهم غير ذلك، وهي أمور مستقبحة في نفس الأمر، وفي مثل هذا قال الشاعر: وللناس فيما يعتقدون مذاهب. أي: قد يستحسن بعضهم ما لا يستحسن غيره.
وما سبق في تعريف الاستحسان بأنه اعتقاد الشيء حسنًا وهو بحسب اللغة والعُرف.
أما في اصطلاح الأصوليين: فقد قيل في تعريفه: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه بأن يفصح عنه بعبارة!!
وهذا هوس؛ لأنّ ما هذا شأنه بأن لا يمكن التعبير عنه، لا يمكن النظر فيه لتُستبان وتُخْتبر صحته من سقمه.
قال الجوهري: الهَوَسُ بالتحريك طَرَفٌ من الجنون.
قلت [الطوفي]: وهو في عُرف الناس [يعني: الهوس]: الكلام الخالي عن فائِدة.
* وقيل في تعريف الاستحسان:
ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أُريد مع دليل شرعي فهو متفق عليه؛ إذِ الدليل الشرعيُّ مُتبَّعٌ، وانضمام العقل إليه لا يضر؛ بل هو مؤكّد، وإن لم يُرد ذلك؛ بل أُريد ما استحسنه المجتهد بعقله المجرّد بدون دليل شرعي فهو ممنوع لوجهين:
أحدهما: أنه لا فرق بين العالم والعامّي إلّا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر، ولم ينضم إلى استحسانه العقلي نظر في أدلة الشرع، فلا فرق إذن بين العالم والعامّي، ويكون ذلك من المجتهد حكمًا بمجرد الهوى واتباعًا للشهوة في الحكم، وذلك باطل شرعًا لقوله ۵: ﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ [ص: 26]، وقوله ۵: ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [مريم: 59].
الوجه الثاني: أنَّ ما ذكروه من تعريف الإحسان إما أن يكون عقليًّا أو سمعيًّا، أي: معلومًا من جهة العقل أو من جهة السمع، وكلاهما باطل، فما ذكره من تعريف الاستحسان باطل؛ لأنه ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي، والدليل منحصر في هذين القسمين:
* وأجود ما قيل في الاستحسان: «أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص». ». اهـ
* أدلة حجّية الاستحسان والردّ عليها:
قال الطوفي، في «شرح الروضة» (3/195 وما بعدها):
«أما المخالفون لما تقدم وهم الحنفية فاحتجوا بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الزمر: 18].
الثاني: قوله تعالى: ﴿ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [الزمر: 55].
الثالث: قوله ڠ: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» [رواه الحاكم في «المستدرك» (4465) موقوفًا عن ابن مسعود وصحّحه ووافقه الذهبي، ولم يصح مرفوعًا].
الرابع: أن الأُمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير للماء المصبوب ولا لمدة المُقام فيه، ولا للأجرة عن ذلك، واستحسنوا شُرب الماء من أيدي السقّائين من غير تقدير عِوَض، فهذا استحسان واقع فيدل على الجواز قطعًا.
والجواب عما ذكرتموه:
أن أحسن القول في قوله تعالى: ﴿ ﮬ ﮭ﴾ [الزمر: 18]، وأحسن المُنَزَّل في قوله تعالى: ﴿ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [الزمر: 55]، هو ما قام دليل رجحانه شرعًا؛ لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرّد؛ يدل على ذلك ما في الآية الأولى: فقوله تعالى: ﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [الزمر: 17-18] هي في سياق التوحيد واجتناب الشرك، وذلك مما لابُدّ له من دليل؛ إذْ لو كان التوحيد ضروريًّا -يعني: يُعلم بالعقل وبالضرورة- لما أشرك أحد.
وأما الثانية: فلقوله تعالى: ﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الأعراف: 3]، والاستدلال واحد.
وأما الخبر: وهو قوله ڠ: «ما رآه المسلمون حسنًا»، فهو دليل الإجماع كما سبق، لا دليل الاستحسان، وإن سُلّم أن له دلالة، فالجواب عنه ما ذُكر من أن المراد: ما قام دليل رجحانه شرعًا؛ أي: ما رآه المسلمون حسنًا مع النظر والاستدلال، وقام دليل الرجحان شرعًا.
وأما استحسانهم دخول الحمام بغير تقدير أجرة ونحو ذلك، فسُومِحَ فيه لعموم مشقة التقدير؛ إذْ يشق جدًّا أن يجعل في الحمام صاع يقدّر به الماء، وبنكام آلة يُقدر به الزمان أو نحو ذلك.
وهذا الحكم مُنْقاس؛ أي: متجه في القياس، والقياس حجة، وليس ذلك من باب الاستحسان، أو لعلّه من باب الإجماع الدال على النص، أو لعل ذلك وقع في زمن النبي ﷺ فأقرّ عليه وإقراره حُجة، وإذا كان هذا الحكم ونحوه يصلح إضافته إلى الإجماع أو النص أو القياس، كان إضافته إلى الاستحسان تحكّمًا». اهـ
* وزاد ابن حزم على الكلام المتقدّم في كتابه الجليل «الإحكام في أصول الأحكام» (2/195/ وما بعدها)، وأذكر منه بعضه فقال $ في إبطال الاستحسان مُختصرًا:
«الباب الخامس والثلاثون في: الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك:
إنما جمعنا هذا كله من باب واحد؛ لأنها كلها ألفاظ واقعة على معنى واحد، لا فرق بين شيء من المراد بها وإن اختلفت الألفاظ، وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال، وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك، وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه….
واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله ۵: ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [الزمر: 18]، وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم؛ لأن الله تعالى لم يقل: فيتبعون ما استحسنوا، وإنما قال: ﴿ ﮬ ﮭ﴾، وأحسن الأقوال: ما وافق القرآن وكلام الرسول ﷺ، هذا هو الإجماع المتيقّن من كل مسلم، وهو الذي بيّنه ۵ إذ يقول: ﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﴾ [النساء: 59]، ولم يقل تعالى: فردّوه إلى ما تستحسنون.
* ومن المحال أن يكون الحق فيها استحسانًا دون برهان؛ لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى كلّفنا ما لا نطيق، ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل وتعارضت البراهين، ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قدْ نهانا عنه، وهذا محال؛ لأنه لا يجوز أصلًا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم، فطائفة طبعها الشدّة، وطائفة طبعها اللين، وطائفة طبعها التصميم، وطائفة طبعها الاحتياط، ولا سبيل إلى الاستحسان على شيء واحد مع هذه الدواعي والخواطر المهيّجة، واختلافها واختلاف نتائجها وموجباتها، ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه المالكيون، ونجد المالكيين استحسنوا قولًا قد استقبحه الحنفيون، فبطل أن يكون الحق في دين الله ۵ مردودًا إلى استحسان بعض الناس، وإنما كان يكون هذا -وأعوذ بالله- لو كان الدين ناقصًا، فأما وهو تام لا مزيد فيه، مبين كله منصوص عليه، أو مجمع عليه، فلا معنى لمن استحسن شيئًا منه أو من غيره، ولا لمن استقبح أيضًا شيئًا منه أو من غيره.
* والحق حقٌّ وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فَصحّ أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال….
واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وهذا لا نعلمه ينْسَنِدُ إلى رسول الله ﷺ من وجه أصلًا، وأما الذي لا شك فيه، فإنه لا يوجد ألبتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود، وهذا لو أتى من وجه صحيح لَمَا كان لهم فيه مُتعلق؛ لأنه إنما يكون إثباتَ إجماع المسلمين فق؛ لأنه لم يقل: ما رآه بعض المسلمين حسنًا فهو حسن، وإنما فيه: ما رآه المسلمون، فهذا هو الإجماع ا لذي لا يجوز خلافه لو تيقن، وليس ما رآه بعض المسلمين بأولى بالاتباع من غيرهم من المسلمين، ولو كان ذلك لكُنَّا مأمورين بالشيء وضدّه، وبفعل شيء وتركه معًا، وهذا محال لا سبيل إليه.
* وقال تعالى: ﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [القصص: 50]، وقوله تعالى: ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [الروم: 29]، وبقوله تعالى: ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ [النازعات: 40]، ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [يوسف: 53].
وهذي الآي إبطالٌ أن يتبع أحدٌ ما استحسن بغير برهان من نص أو إجماع، ولا يكون أ حد أحوط على العباد المؤمنين من اللهِ خالقهم ورازقهم وباعث الرسل إليهم، والاحتياط كله اتباع ما أمر الله تعالى به، ….
وقد اعترف مالك $ بالحق في هذا وبرئ ممن قلده كما حدثنا … حدثنا سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك: أنه كان يُكثر أن يقول: «إن نَظُنُّ إلا ظنًّا وما نحنُ بمُستيقنين».
ونحن نقول لمن قال بالاستحسان: ما الفرق بين ما استحسنت أنت واستقبحه غيْرك، وبين ما استحسنه غيرك واستقبحته أنت؟! وما الذي جعل أحد السبيلين أوْلى بالحق من الآخر؟ وهذا مما لا انفكاك منه وبالله تعالى التوفيق». اهـ
قلت: هذا ما قاله الإمام ابن حزم يُظهر هدم الاستحسان بالدليل والبرهان، وهو أ حسن ما اسْتُدِل به في هذا المبحث، وكل ما قيل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الاستحسان عن بعض أصحابهم، فإنه يُنَزَّل على ما نقلته آنفًا من الفرق بين الاستحسان الباطل الذي يخالف الأدلة الشرعية ويتبع الهوى وهذا لا يقول به أحد ألبتّة من أهل العلم، والاستحسان الثاني الذي نُسِب إليهم، وليس هو الاستحسان المراد؛ بل هو شيء آخر كما ذكرنا من تعريف الاستحسان بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص لوجه أقوى منه، ومن دليل إلى دليل أقوى منه، وهذا مما لم ينكره أحد عليهم، لكن هذا الاسم لا يعرف اسمًا لما يقال به بمثل هذا الدليل كما قاله السمعاني.
وعليه، فإن الراجح والمحقّق في هذه المسألة: إبطال الاستحسان كما سمّاها الشافعي كذلك في كتابه «الأم» (8/44 وما بعدها)، وكما فعل ابن حزم، وهو الحق الذي يتضح من النقولات السابقة.
* فأختم هذا البحث بما قاله الإمام الشافعي في «الأُمّ» (8/33-57) مختصرًا. قال $:
«باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت من حكم الله ثم حكم رسوله ﷺ ثم حكم المسلمين؛ دليل على أنْ لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا أو مُفْتيًا، أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبرٍ لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا لا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذْ لم يكن الاستحسان واجبًا ولا واحد من هذه المعاني.
فإن قال قائل: فما يدل على أنْ لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا؟
قيل: قال الله ۵: ﴿ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [القيامة: 36]، فلم يختلف أهل العمل بالقُران فيما علمت أن السُّدَى الذي لا يُؤْمر ولا يُنهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السُّدَى، وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سُدًى، ورأى أن قال: أقول بما شئت وادَّعَى ما نزل القُرانُ بخلافه في هذا، وفي السننِ فخالفَ منهاج النَّبيِّين، وعوامَّ حُكْم جماعة من رُوِيَ عنه من العالمين.
فإن قال: فأين ما ذكرت من القرآن ومنهاج النبيين -صلى الله عليهم وسلم أجمعين-؟
قيل: قال الله لنبيّه -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [الأحزاب: 2]، وقال: ﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [المائدة: 49]، الآيتين، … ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان بأنَّ معنى قوله افعل ما هوِيت وإنْ لم أُمَرْ به مخالف معنى الكتاب والسنة فكان محجوجًا على لسانه، ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفًا.
فإن قيل: ما هو؟
قيل: لا أعلم أحدًا من أهل العلم رخّص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يُفتي ولا يحكم برأيِ نَفْسِه إذا لم يكن عالمًا بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفصيل المُشْتبه، فإذا زعموا هذا قيل لهم: وَلِمَ لَمْ يَجُزْ لأهل العقول التي تفوق كثيرًا من عقول أهل العلم بالقُران والسنة والفتيا، أن يقولوا فيما قد نزل مما يعلمونه معًا، أنْ ليس فيه كتاب ولا سُنة ولا إجماع، وهم أوْفر عقولًا وأحسن إبانة لما قالوا من عامتكم؟
فإن قلتم: لأنهم لا عِلْمَ لهم بالأصول.
قيل لكم: فما حجتكم في علمكم بالأصول؛ إذ قلتم بلا أصل ولا قياس على أصل؟
[قال الشافعي]: أفرأيت إذا قال الحاكم والمفتي في النازلة ليس فيها نص ولا خبر ولا قياس وقال: أستحسن، فلا بُدّ أن يزعم أنّ جائزًا لغيره أن يستحسن خلافه، فيقول كل حاكم في بلد ومفتٍ بما يستحسن، فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا، فإن كان هذا جائزًا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا». اهـ
قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فقد ثبت بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والحجة والبرهان ما قاله الإمام ناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي -رحمة الله عليه-: «من استحسن فقد شَرَّع»، وقد قال الإمام ابن حزم مثل ذلك وأشدّ.
قال الله تعالى: ﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [فصلت: 33].
وقال ۵: ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [الزمر: 23].
وقال العليم الحكيم: ﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [هود: 1].
وقال: ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [الكهف: 1-2].
وقال: ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [البينة: 3].
وقال تعالى: ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [يونس: 57-58].
روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (15635) عن أبي عمرو الزجاجي محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت348هـ) قال:
«كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردّهُمُ النبيّ ﷺ إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة، ويستقبح ما تستقبحه».
وقال (15637): «قسّم الله الرحمة لمن اهتم لأمر دينه».
قلت: وهذا بيان سلفي على ضلال التحسين والتقبيح العقلي المعتزلي.
وقال الإمام ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (1/7):
«قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبًا داهيًا فَطِنًا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله ۵».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (9/279):
«ولما رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنّة، كما قال تعالى: ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [الرعد: 35]، وقال: ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [ص: 54]، ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيما خالف فيه أهل العقل، ولم يعلموا أن الحجة العقلية الصحيحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة؛ بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة، سواء كانت عقلية أو سمعية، أو سمعيةً وعقلية، بل إذا تعارضت حجتان: دل على فساد إحداهما أو فسادِها جميعًا». اهـ
قلت: وما قاله شيخ الإسلام $، واضح بيّنٌ في زَيْف التحسين العقلي القائم على الهوى والتشهي وهو أصل المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي.
وبهذا مسك الختام، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله وسلم على محمد النبيّ وآله وصحبه أجمعين.
كتبه
الدكتور: عيد بن أبي السعود الكيال