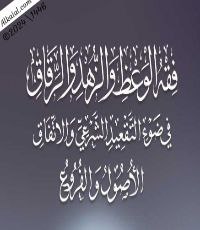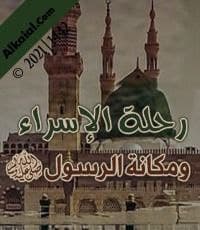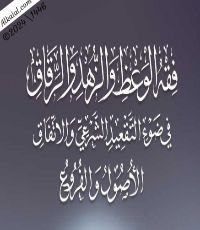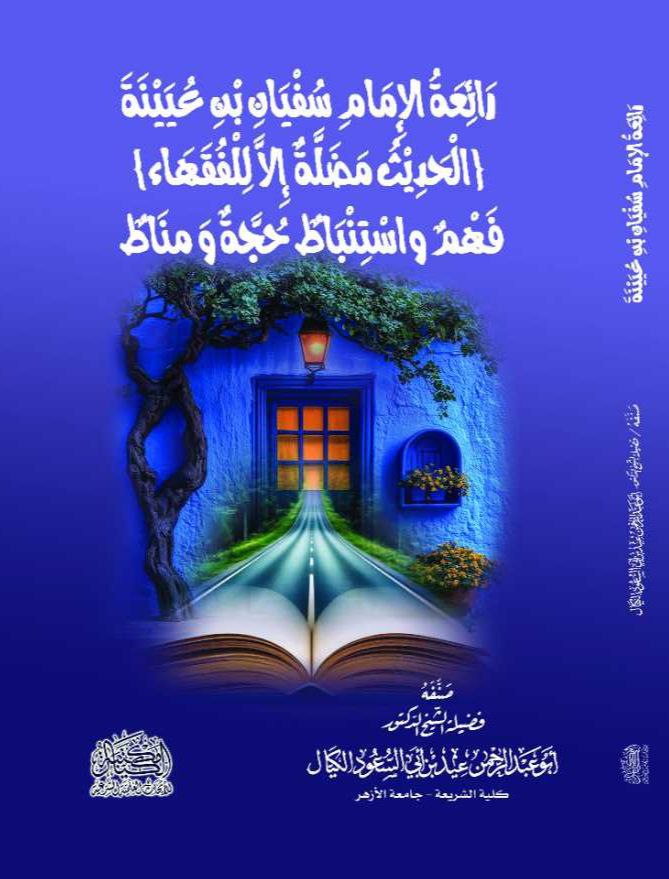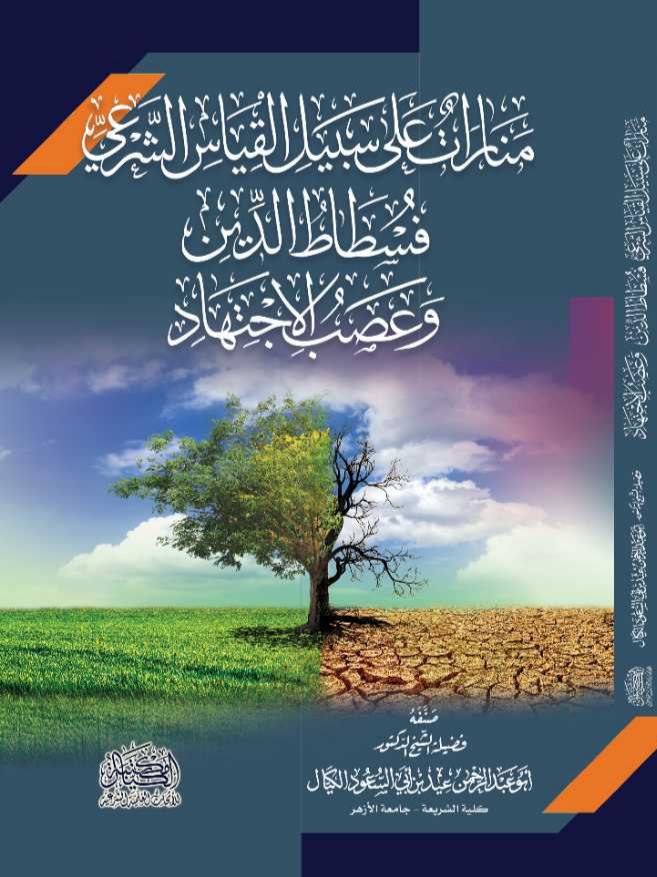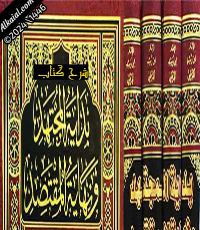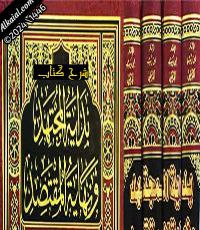«تمهيد عام»
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده ﷺ، أما بعد:
فلقد قال الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المشهور بالقرافي في كتابه: «الفروق» (2/453-547) الفرق الثامن والسبعون: «بين قاعدة من يجوز له أن يفتي، وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي»، حيث فصّل القول في هذه البابة، فتكلم على التقليد والاجتهاد وتخريج الأقوال على الأصول والقواعد فقال:
«فمهما جوز المقلد في معنى ظفر به في فَحْصِهِ واجتهاده أن يكون إمامه قصدوه أو يراعيه، حرم عليه التخريج فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة، والعلل، ورُتب المصالح، وشروط القواعد، وما يصلح أن يكون عارضًا وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة، فإذا كان موصوفًا بهذه الصفة وحصل له هذا المقام، تعين عليه مقام آخر، وهو النظر، وبذل الجهد، في تصفّح تلك القواعد الشرعية، وتلك المصالح، وأنواع الأقيسة وتفاصيلها،…. وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرّج فرعًا أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته، كما إن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسُّنَّة وأقضية الصحابة، ولم يكن عالمًا بأصول الفقه حَرُم عليه القياس والتخريجات على المنصوصات من قِبَل صاحب الشرع، بل حَرُم عليه الاستنباط من نصوص الشارع؛ لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه». اهـ.
(*) الشريعة من أوّلها إلى آخرها مبْنيّة على أصول الفقه:
ثم قال القرافي في كتابه «الفروق» (2/670) الفرق الثالث عشر والمائة: «بين قاعدة التفضيل بين المعلومات»:
«علم النحو مع علم أصول الفقه كلاهما مُثمرٌ، غير أن أصول الفقه يُثمر الأحكام الشرعية، فإنها منه تؤخذ، فالشريعة من أوّلها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه، والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ والمعاني، والألفاظ إنما هي وسائل، والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل». اهـ.
لذلك قال الإمام الحنبلي الفقيه الأصولي عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت616 هـ) فيما نفله عنه ابن النجار في كتابه: «شرح الكوكب المنير» (1/48):«أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه». اهـ.
وانظر للمزيد على هذا الأصل: مقدمة كتابي: «الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه»، وكتابي: «أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد وردّ شُبه المنحرفين»، ومقالتي: «صفة من يتكلم في النوازل»، و«آلية الترجيح في المسائل الشرعية».
(*) الدخول في موضوع المقال: الأحكام الشرعية وأدلتها:
ثم أما بعد: فعلى ضوء ما تقدم آنفًا يعلم: أن الأحكام الشرعية الخمسة التي تعبّدنا الله بها وهي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، لا يتوصل الناظر إليها إلا بآلية الاستنباط وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة، والأدلة الشرعية التي هي الأصول المعتمد عليها في تقرير العبادات إنما هي: القرآن والسُّنَّة والإجماع والقياس الصحيح، والتي هي محل نظر المجتهدين والمستنبطين للوصول إلى معرفة الحلال والحرام وضوابط الفتوى والتكلم في دين الله.
(*) السُّنَّة النبوية قولية وفعلية وتقريرية:
والسُّنَّة النبوية هي الدليل الثاني والأصل الذي يلي كتاب الله ۵، قال تعالى: ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ[النحل: 44]، فهي المبيِّنة للقرآن، لذلك قال السلف: «القرآن أحوج للسنة من السُّنَّة للقرآن» وهذا بنص القرآن نفسه، كما في الآية السابقة آنفًا، حيث قال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [النساء: 80]، وقال: ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النساء: 65] فالسُّنَّة تخصص عموم القرآن، وتقيد مطلقه، وتبيّن مُجْمَله، وتفصّل قواعده الكلية وقوانينه العامة.
(*) والسُّنَّة منها القولية بنص كلام رسول الله ﷺ الذي رواه البخاري في صحيحه (1) ومسلم (1907): «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وقوله المتفق عليه: «بُني الإسلام على خمس….» الحديث، رواه البخاري (8) ومسلم (16)، وحديث: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» رواه البخاري (2079) ومسلم (1532).
(*) وهناك السُّنَّة الفعلية وهي المأخوذة عنه في كل العبادات والمعاملات والتي أقرَّها ﷺ بقوله الذي رواه البخاري (631) ومسلم (44/391) في صحيحهما: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (310/1297).
(*) ومنها السُّنَّة التقريرية وهي إقراره ﷺ على شيء من أقوال الصحابة وأفعالهم أمامه، كما أقرّهم على أكل الضب حيث أكله خالد بن الوليد، كما عند البخاري (5400) ومسلم (44/1946) في «صحيحهما».
(*) النظر الفقهي الأصولي المتميز الدقيق الاستنباطي الاجتهادي إلى هذه السُّنَّة يُثمر علمًا جمًّا وأحكامًا الناس في أمسّ الحاجة إليها: تترتب هذه الأحكام على معرفة مراتب السُّنَّة النبوية وحسن تحليل السُّنَّة، فيثمر هذا التحليل الأصولي: الإلمام بالسُّنَّة التي تعتبر تشريعًا عامًا في كل زمان ومكان لا يتقيد بشرط أو سبب، بل هو دين لكل الناس في كل زمان ومكان وحال، وهذا حال غالب السنّة.
(*) والإلمام بالسنن التي تَصَرّف فيها رسول الله ﷺ بكونه وصفته قاضيًا يقضي بين الناس؛ على حسب الأسباب التي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان، فيختلف ما قضى به باختلاف حالات القضاء، ويكون التشريع العام في هذه السنن من جهة أخرى وهي طريقته ﷺ في القضاء، لا عين ما قضى به فبينهما فرق، فيكون التعويل على أصوله ومنهجه في القضاء، ولو ظهرت طرق أخرى للفصل بين أقضية الناس لم تكن على عهده ﷺ ما دامت في عموم طريقته ﷺ في القضاء.
(*) وكذلك السنن التي تصرّف فيها ﷺ بمنصب الإمام حاكم البلاد، والتي راعى فيها مصالح المسلمين، هذه المصالح التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال؛ كما منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال بسبب ظهور المحتاجين، ثم لما جاء العام الذي بعده قال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا» رواه البخاري (5570) ومسلم (28/1971).
ولأهمية هذا النظر الأصولي المتمّيز، كتب الإمام القرافي في هذه المسألة كتابه المتميّز «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» وقد استفدت من هذا الكتاب مع غيره في رسالة الماجستير والتي سمّيتها: «الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد» فبيّنت فيها حدود سلطة ولي الأمر في ذلك وضوابطها في تنظيم البلاد، كما استفدت بالكتاب القيم لابن القيم «الطرق الحكمية» وهو متميز في بابه لا غنى للقضاة والحكام عنه، وفيه تفصيل منصب القضاء والحكم وتصرفات القاضي والإمام.
فعقد القرافي في كتابه «الإحكام» أربعين سؤالًا وأجاب عليها في هذا الباب ففصّل القول، وحجم الكتاب (144) صفحة، وتكلم باختصار في كتابه «الفروق» (1/346-350) الفرق السادس والثلاثون، وجعل في كتابه «الإحكام» السؤال الخامس والعشرين في تفصيل الفرق بين ذلك، وكلامه في الفروق أخصر وأضبط فأعوّل عليه هنا:
فقال القرافي $ في «الفروق» (1/346-350) الفرق السادس والثلاثون «بين قاعدة تصرفه ﷺ بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ، وبين قاعدة تصرفه ڠ بالإمامة» فقال:
«اعلم أن رسول الله ﷺ هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فهو ﷺ إمام الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية فوّضها الله تعالى إليه في رسالته، وهو أعظم مِنْ كل مَنْ تولىَّ منصبًا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة، فما مِنْ منصب دينيّ إلّا وهو متصف به في أعلى رُتبه، غير أن غالب تصرّفه ﷺ بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب فيه.
[(*) نقل الإجماع على تقسيم سُنة النبي ﷺ إلى التشريع العام والقضاء والإمامة]:
ثم تقع تصرفاته ﷺ منها: ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعًا، ومنها: ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ومنها: ما يجمع الناس على أنه بالإمامة، ومنها: ما يختلف العلماء فيه لتردّده بين رُتبتين فصاعدًا، فمنهم من يُغلّب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى، ثم تصرفاته ﷺ بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، فكل ما قاله ﷺ أوْ فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكمًا عامًّا على الثقلين إلى يوم القيامة، فإنْ كان مأمورًا به أقدم عليه كلُّ أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهيًّا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه.
وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلّا بإذن الإمام اقتداء به ڠ؛ ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك، وما تصرف فيه ﷺ بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلّا بحكم حاكم يقتضي ذلك، وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاث، ويتحقق ذلك بأربع مسائل:[أربعة مُثُلٌ توضح المقصود من المسألة]:
المسألة الأولى: بعث الجيوش لقتال الكفّار والخوارج ومن تعيّن قتاله، وصرف أموال بيت المال في جهاتها، وجمعها من محالّها، وتولية القضاة والولاة، وقسمة الغنائم، وعقد العهود للكفار ذمة وصلحًا، هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم ، فمتي فعل ﷺ شيئًا من ذلك علمنا أنه تصرّف فيه ﷺ بطريق الإمامة دون غيرها.
(*) ومتى فصل بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبيّنات أو الأَيْمان والنكولات ونحوها، فنعلم أنه ﷺ إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة وغيرها؛ لأن هذا هو شأن القضاء والقضاة.
(*) وكل ما يتصرف فيه ﷺ في العبادات بقوله، أو بفعله، أوْ أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجاب فيه، فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ.
فهذه المواطن لا خفاء فيها، وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل.
(*) [سنن تردد فيها العلماء في أي مرتبة تكون؟]
المسألة الثانية: قوله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»([1]) اختلف العلماء في هذا القول، هل تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي دون إذن الإمام في ذلك الإحياء؟ وهو مذهب مالك والشافعي، أو هو تصرف منه ڠ بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلّا بإذن الإمام؟ وهو مذهب أبي حنيفة $.
ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح؛ لأن الغالب في تصرّفه ﷺ الفتيا والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أوْلى([2]).
المسألة الثالثة: قوله ﷺ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له ﷺ: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها ڠ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»([3])، اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذا التصرف منه ڠ هل هو بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به، وهو مذهب الشافعي $، أوْ هو تصرف بالقضاء، فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذّر أخذه من الغريم إلّا بقضاء قاض؟ حكى الخطابي القولين عن العلماء في هذا الحديث.
حجة من قال: إنه بالقضاء: لأنها دعوى في مال على معيّن فلا يدخله إلا القضاء؛ لأن الفتاوى شأنها العموم.
وحجة القول بأنها فتوى: ما روى أن أبا سفيان كان بالمدينة، والقضاء على الحاضر من غبر إعلام ولا سماع حجة لا يجوز، فيتعيّن أنه فتوى، وهذا هو الظاهر من الحديث([4]).
المسألة الرابعة: قوله ﷺ: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه»([5]): اختلف العلماء في هذا الحديث، هل تصرف فيه ﷺ بالإمامة فلا يستحق أحد سلب المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك، وهو مذهب مالك $، فخالف أصله فيما قاله في الإحياء، وهو أن غالب تصرّفه ﷺ بالفتوى، فينبغي أنْ يُحمل على الفتيا عملًا بالغالب، وسبب مخالفته لأصله هنا أمور، منها: أن الغنيمة أصلها أن تكون للغانمين لقوله ۵: ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الأنفال: 41]، وإخراج السَّلَب من ذلك خلاف هذا الظاهر.
ومنها: أن ذلك ربما أفسد الإخلاص عند المجاهدين فيقاتلون لهذا السبب دون نصر كلمة الإسلام، ومن ذلك: أنه يؤدّي إلى أن يُقبل على قتل من له سلب دون غيره؛ فيقع التخاذل في الجيش، وربما كان قليل السلب أشد نكاية على المسلمين، فلأجل هذه الأسباب تُرك هذا الأصل([6]).
(*) وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرّج ما يرد عليك من هذا الباب من تصرفاته ﷺ، فتأمّل ذلك فهو من الأصول الشرعية» اهـ.
وكذلك قال القرافي في «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 45/وما بعدها):
«تصرف رسول الله ﷺ بالفتيا هو: إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى، كما قلنا في غيره ﷺ من المفتين، وتصرفه ﷺ بالتبليغ هو: مقتضى ما ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن الله تعالى، فهو في هذا المقام مبلّغ وناقل عن الله تعالى، ورث عنه ﷺ هذا المقام المحدّثون رواة الأحاديث النبوية وحملة كتاب الله العزيز لتعليمه للناس، كما ورث المفتي عنه ﷺ الفتيا، فكما ظهر الفرق لنا بين المفتي والرَّاوي، فكذلك يكون الفرق بين تبليغه ﷺ عن ربّه وبين فتياه في الدّين، والفرق هو الفرق بعينه، فلا يلزم من الفتيا الرواية، ولا من الرواية الفتيا من حيث هي رواية وفتيا.
وأما تصرفه ﷺ بالحكم، فهو مغاير للرسالة والفتيا؛ لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرف، والحكم إنشاء وإلزام من قِبَلِهِ ﷺ بحسب ما نتج من الأسباب والحِجَاج وقوة اللحن بها([7])، فهو ﷺ في هذا المقام مُنشئ، وفي الفتيا والرسالة متبع مبلغ، وهو في الحكم أيضًا متبع لأمر الله تعالى له؛ بأن ينشئ الأحكام على وفق الحِجاج والأسباب؛ لأنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى؛ لأن ما فوض إليه من الله لا يكون منقولًا عن الله([8])». اهـ.
قلت: نقل القرافي إجماع الناس على تقسيم سنته ﷺ إلى هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، القسم الأول: وهو الأصل الأم وهو التبليغ والتشريع العام وهو لُبّ الرسالة ومقصودها وجُلّها والإجماع عليه بلا خلاف ألبتة، والقسم الثاني: وهو تصرفه ﷺ بمنصب الإمامة يكون فيها ناظرًا إلى المصلحة العامة التي تتغير بتغير الأحوال، كما ذكرت من قبل نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم سماحه بذلك، والنهي لعلة مصلحة الفقراء، فلما ارتفعت العلة رُفع النهي وهذا أيضا نقل القرافي عليه إجماع الناس، وفي هذا القسم تنظر الأئمة من بعده ﷺ إلى ما ينصلح به حال البلاد والعباد فيلتزموا به؛ لذلك قعّد الشافعي قاعدة في هذا الباب نصها: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» ذكرها ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» (ص106)، والسيوطي في «الأشباه والنظائر» (1/278) حيث قال: «هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: «منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم» قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر ﭬ: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استخففت». اهـ.
قلت: ويؤكد ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» (7151) ومسلم (1829) أن النبي ﷺ قال: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة»، وفي رواية للبخاري (7150): «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنُصحه»، وفي رواية لمسلم (21/1829): «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وهذا حال رسول الله ﷺ كأمير للمؤمنين ينظر للصالح العام للأمة، كما فعل في صلح الحديبية الذي رواه البخاري في «صحيحه» (2731، 2732) من الهدنة عشر سنين مع قريش يوقف فيها الحرب، وهو أمر راجع لاجتهاد الإمام فقد يكون من المصلحة الهدنة بدون حرب أكثر من عشر سنين؛ لضعف المسلمين وهوانهم، أو من المصلحة الحرب وعدم الهدنة، أو أن تكون أقل من عشر سنين، فذكر المدة في بعض روايات الحديث لا يعني التزام الأئمة من بعده بها، بل هو أمر راجع إليهم منوط بالمصلحة ومنسوج بها لا ينفصل عنها، فكان اتباعه في السنين التي قالها أو فعلها تبعًا لمنصب الإمامة اتباع منهج وطريقة تابعة لجلب المصالح ودفع المفاسد، كما حدث في لحوم الأضاحي؛ لأن العلة حاجة المسلمين، فإن وجدت الحاجة جاز لولي الأمر منع ادخار لحوم الأضاحي حتى تتسع للفقراء، فلا يقال إنه ﷺ أباح الادخار بعد المنع وهذا نسخ، لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وأوجه الجمع موجودة، منها: ارتفاع الحكم بارتفاع علّته، ورجوع الحكم برجوع علته، وهذا مقدّم قطعًا على النسخ الذي فيه تعطيل للنص، والقاعدة: «الإعمال أولى من الإهمال»، وقد يمنع الادخار ثلاثة أيام أو أكثر على حسب المصلحة.
ومما يدخل تحت هذا الباب، ما ذكرته في رسالتي في الماجستير، وهو الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» (977) قال ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم».
فنظرت إلى العلة من منع زيارة القبور في بداية الإسلام فوجدتها حماية جناب التوحيد من الشرك وتعلق قلوب المسلمين بالأموات وهم حديثو عهد بالإسلام، فخشي ﷺ عليهم الشرك فنهاهم، فقدّم دفع المفسدة على جلب المصلحة التي هي تذكير الآخرة، كما في رواية للحديث، فلما استقر التوحيد في قلوبهم وارتفع الخوف عليهم أباح لهم زيارة القبور.
فقلت – ردًّا على من قال بنسخ النص-: إن النهي ليس منسوخًا؛ بل ارتفع بارتفاع العلة، فإن وجدت مرّة أخرى يعود النهي، فإذا أتى زمان وتعلقت به قلوب الجهال بالمقابر والأضرحة في جلب النفع ودفع الضرر، كان من الحكمة والمصلحة الدعوية لصيانة جناب التوحيد أن يمنع ولي الأمر الناس من زيارة القبور حتى يرجع الناس إلى صحيح الدين والمعتقد السليم.
فكان تصرُّفه ﷺ بمنصب الإمامة قائمًا على جلب المصالح ودفع المفاسد، الأمر الذي جعل الأئمة من بعده يتصرفون بمرونة ويُسْر سائرين على منهجه وطريقته في الإمامة بروح مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وفهم ما ينفع الناس من غير مخالفة للسنة أو النصوص الشرعية، تحت الأصل العام «المصلحة المرسلة» بضوابطها الشرعية، من غير لزومٍ لوجود نصٍّ في كلِّ مسألة بعينها.
وعليه ظهر الاختلاف بين مرتبة التشريع العام والتبليغ من مرتبة الإمامة وكلاهما سنة وتشريع متّبع؛ لذلك ذكر القرافي حديث الإحياء وإلزام الناس بإذن الإمام فيه، مع أن الحديث عام ومطلق من القيد والشرط، ولكن لما كان الإذن دافعًا لمفسدة الطمع والجشع والشقاق المؤدي إلى استباحة الدماء، كان تقييد الحديث بمنصب الإمامة من الدين ومقاصده الكلية، وكذلك حديث السَّلَب، إذْ ليس في الحديثين منع ونهي عن التقييد والاشتراط، وقد تقرر أن الإمام يجوز له تقييد المباح لو وجد في ذلك مصلحة، ولنا في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان في منعهم الحُجّاج من التمتع والقرآن وإلزامهم بالإفراد حتى يُعمّر البيت طوال العام، والتمتع أمر رسول الله ﷺ والقرآن فعله وسنته ﷺ، وفعل الخلفاء في ذلك رواه مسلم في «صحيحه» (157/1222)، (158/1223)، (159)، والأمثلة على ذلك من السُّنَّة كثيرة لا يسعها مقام الاختصار، وقد ذكر ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص32-33) فعل الخلفاء هذا فإذا كان ذلك كذلك اتضح عندك الفرق بين مرتبة التبليغ والتشريع العام من السُّنَّة، وبين مرتبة الإمامة منها، وما يترتب على ذلك من تصرّفات.
ومن أفضل ما كُتب في هذا الباب كتاب «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم $ فاقرأه لازمًا؛ فإن المقال مقام الاختصار.
(*) ذكر الدليل على صحة تقسيم السُّنَّة إلى المراتب الثلاث إضافة إلى الإجماع السابق:
وهو ما قرَّره ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية»: وها أنا أذكر منه قسطًا يسيرًا، فقال (ص 26/وما بعدها):
«وقال ابن عقيل في «الفنون»: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال الشافعي: «لا سياسة إلّا ما وافق الشرع»، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ﷺ ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك: «إلا ما وافق الشرع» أي: ما يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط، وتغليط للصحابة؛ فقد جري من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلّا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق عليٍّ ﭬ الزنادقة في الأخاديد وقال في الرجز:
«لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أجّجّت ناري ودعوت قَنْبرا».
ونفي عمر بن الخطاب ﭬ لنصر بن حجاج. اهـ [قال ابن القيم]: ومنع النبي ﷺ القاتل من السَلَبَ لما أساء شافعه على أمير السرية، فعاقب المشفوع له عقوبة الشفيع([9])، وعزم على تحريق تاركي الجمعة والجماعة([10])، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم الحرام([11])، وأمر عبدالله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين فسجرهما في التنور([12])، وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلّى سبيلها([13])، وكذلك العرنيون فعل بهم ما فعل بناء على شاهد الحال ولم يطلب بيّنة بما فعلوا ولا وقف الأمر على إقرارهم([14])، وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعد ما هو معروف لمن طلبه، فمن ذلك: أن أبا بكر ﭬ حرّق اللوطية وأذاقهم حرّ النار في الدنيا قبل الآخرة، وحرق عمر ﭬ حانوت الخمار بما فيه وحرّق قرية يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرَّعية، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشيب النساء به – يعني فتن النساء بجماله -… والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين، الأجر والأجرين، وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي تأويل القرآن والسُّنَّة، ولكن: هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟». اهـ.
قلت: بل الثاني بلا شك، فكل ما ذُكر من النصوص النبوية دليل على تنوع التصرفات بتغير الأحوال، ودليل ذلك ما فعله الخلفاء من فعل أبي بكر وعمر ﭭ وهي أفعال لم يفعلها النبي ﷺ، ولكنها كلها دائرة في فلك السُّنَّة وروحها وفقهها، وإن خالفتها في الصورة الخارجية، وهذا المطلوب الاستدلال عليه.
وما قرّره القرافي قرّره ابن القيم في «زاد المعاد في هدى خير العباد» (3/421-422) حيث ذكر حديث السَّلَب، وأقوال العلماء في استحقاق السلب بالشرع أو بشرط الإمام؟ فذكر لأحمد روايتان، ثم قال:
«ومأخذ النزاع: أن النبي ﷺ كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعًا إلى يوم القيامة، كقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»([15]) وقوله ﷺ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته»([16])، وكحكمه «بالشاهد واليمين»([17])، «وبالشفعة فيما لم يُقسم»([18]) وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فهذه فتيا لا حكم، إذْ لم يَدْع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سأله البيّنة.
وقد يقول بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبيّ ﷺ زمانًا ومكانًا وحالًا([19]).
ومن هاهنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه ﷺ، كقوله ﷺ: «من قتل قتيلًا فله سلبه»، هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقًا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعًا عامًّا؟، وكذلك قوله: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» هل هو شرع عام لكل أحد، أذن فيه الإمام أولم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك الإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، والثاني لأبي حنيفة» اهـ.
(*) لا تأثير لمنصب الإمامة والقضاء في تغيير الأحكام التكليفية إلَّا التقييد والشرطية المصلحية:
(*) تنبيه: واعلم أن منصب الإمامة والقضاء لا يغيّران صفة السُّنَّة من الأمرية أو التحريمية إلى غيرها، بل كل ما يحدث هو: التقييد أو الشرطية بمنصب الإمامة كما في حديث الإحياء والسَّلَب، أو التخصيص بالقضاء كحديث هند، ولا يحدث ذلك إلا بمستند شرعي وضابط ديني وفق مقاصد الدين، وعليه فلا تأثير على الأحكام التكليفية هنا إلا بتقييد المباح، أو إحداث سياسة مصلحية.
(*) ثمرة التفرقة بين تصرفاته ﷺ الثلاثة:
قال القرافي في كتابه: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 50- 51):
«فقد ظهر افتراق هذه الحقائق بخصائصها، وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة: فما فعله ڠ بطريق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في الأراضي والمعادن، ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلَّا بإذن إمام الوقت الحاضر؛ لأنه ڠ إنما فعله بطريق الإمامة، وما استبيح إلّا بإذنه فكان ذلك شرعًا مقررًا؛ لقوله تعالى: ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الأعراف: 158].
وما فعله ڠ بطريق الحكم، كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة، والعقود، والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق، والإيلاء والفيء ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر؛ اقتداء به ﷺ؛ لأنه ڠ لم يقرر تلك الأمور إلّا بالحكم، فتكون أمته بعده ڠ كذلك.
وأما تصرفه ڠ بالفتيا أو الرسالة أو التبليغ، فذلك شرع يقرر على الخلائق إلى يوم الدين يتّبع كل حكم مما بلّغه إلينا عن ربه بسببه من غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام؛ لأنه ڠ مبلغ لنا، ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب، وخلّى بين الخلائق وبين ربهم، ولم يكن منشأ لحكم من قبله ولا مرتبًا له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحة، بل لم يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه، كالصلاة والزكاة وأنواع العبادات، وتحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبات، وغير ذلك من أنواع التصرفات لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه، ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى حكم حاكم أن ينشئ حكمًا، وإمام يجدد إذنًا». اهـ.
قلت: وهو كلام متين قويّ متّجه على النصوص الشرعية وقواعد الملّة.
فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى في هذا المقال من خلال هذه النقولات، فلابد من وضع ضابط لمعرفة هذه المراتب الثلاث والتمييز بينها فأقول:
(*) بيان الضابط الذي يعرف به التبليغ والتشريع العام ممّا كان حاله القضاء والإمامة الكبرى من سنن رسول الله ﷺ:
إن معرفة الضابط الذي تُضبط به مراتب السُّنَّة النبوية والفرقان الذي يُفرَّق به بين التبليغ العام ومرتبة القضاء والإمامة الكبرى، لأمْر في غاية الأهمية والخطورة؛ لما يترتب عليه من تمييز السنن بعضها عن بعض، الأمر الذي يؤدي إلى تنوع الأحكام المستنبطة من السُّنَّة، وتخصيص عموم حديث رسول الله ﷺ وتقييده بإذن ولي الأمر، أو حكم القضاء والأصل عدمهما، فإن لم يُعْرف هذا الضابط حدث الاضطراب التشريعي وخُصّصت السُّنَّة وقيّدت بغير مستند شرعي؛ لأن التخصيص والتقييد دين ولا يكونا إلا بدليل معتبر.
ويظهر هذا الضابط فيما فصّله القرافي في «الفروق» كما مرّ مفصلًا وحاصله:
(1)- أن الأصل في تصرفاته وسننه ﷺ القولية والفعلية هي التشريع العام والتبليغ لكل الأمة، فلا تُصْرف عن هذا الأصل إلا بدليل وحجة وبرهان، فيدخل تحت ذلك كل الدين العبادات والمعاملات والمعتقدات والأخلاق والشريعة كلها.
(2)- النظر إلى طبيعة التصرف يحدّد الصارف عن الأصل الأم وهو التشريع العام والتبليغ، فيُعرف كون هذا التصرف من قِبَل الإمامة الكبرى بالنظر لطبيعة التصرف، فشأن الخليفة والإمام الأعظم أن يدير شئون البلاد الداخلية والخارجية، فكل ما كان من هذا الصنف فهو من باب الإمامة، كأمور الجيوش وما يتعلق بها، وتولية الولاة والقضاة والوزراء ورجالات الدولة والولايات العامة، والتصرف في المال العام بالتحصيل والتقسيم والاستعمال والتوجيه والتسبيب من خلال إدارة الأعمال والوزارات والشئون العامة، وما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى والأمصار المسلمة وغير المسلمة، وما يجريه معهم من عقود وعهود وصلح وحرب وغير ذلك مما يتعلق بمجالات السلم والحرب والاقتصاد والمعاملات، وكل ما هو قريب من هذه التصرفات ومثلها، وكلها مرتبطة بالمصلحة العامة للبلاد، فطبيعة التصرف تُطغي عليه صفته المناسبة والخاصة به، ومن ثم، تتميز تصرفاته ﷺ بكونه قاضيًا يفصل بين الناس في خصوماتهم فيُفصل كل ما كان كذلك -على التفصيل السابق- عن الأصل الأم الذي هو التشريع العام والتبليغ الكلّي.
(3)- لما كانت القاعدة الفقهية: «الحكم للغالب ولا حكم للنادر» فإذا اعتبرت هذه القاعدة وتردد التصرّف بين كونه تشريعًا عامًّا وحكمًا للجميع وهو الغالب في السنن وبين كونه بالإمامة أو القضاء، فالأصل أنه تشريع عام، إلّا أن يكون التردد ضعيفًا وحقيقته القرب من الإمامة أو القضاء، ويُفهم هذا من السياق، كما مرّ من حديث هند: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ويحتاج ذلك إلى تدبّر السنن ومعرفة أسباب ورود الأحاديث، التي هي كأسباب نزول الآيات، والنظر في ألفاظ الحديث ومعانيها وفهمها فهمًا جيّدًا، مع مراعاة مقاصد الشريعة والقواعد الكلية التي قام عليها هذا الدين، فمثلًا حديث هند المذكور، الأوْلى أن يحمل على التشريع العام؛ مراعاة لمصالح الناس، فكم من رجال قد ابتلوا بالشح والبخل مما يدفعهم للتقصير في الإنفاق، فإن رفع أمره إلى القضاء فقد يتحايل لعدم الدفع والهروب من المسئولية، فإن أخذت من ماله وهو لا يشعر ما يكفيها وأولادها لانقضت المصلحة من غير أن يشعر أنه فُجِع في ماله، مما يدفع شرّه عن أولاده وزوجه، ومن هنا تكلم الفقهاء عن مسألة الظفر بالحق وصورتها: مطل الغني عن ردّ الحق أو جحده له، فيظفر صاحب الحق بحقه من مال المماطل فيأخذه سِرًّا لاضطراره لذلك لدفع الظلم عن نفسه، وإيصال الحقوق لمستحقيها، وردّ المظالم، ونشر العدل، أصول شرعية وقواعد كلية ومقاصد من مقاصد هذا الدين.
ونفس الأمر في حديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» فإن حب المال والحرث والأراضي والملك يدفع الناس إلى الطمع والظلم والأثرة، وأن يأكل القوي الضعيف، ولا ينضبط كل ذلك إلا بعصى السلطان وزجره، ودفع هذه المفاسد يكون باشتراط الإحياء بإذن ولي الأمر، وإنما يحدث هذا باعتبار هذا الحديث تصرفًا من قِبَل الإمامة لا بكونه تشريعًا عامًّا وتبليغًا، فكان النظر إلى الحديث الأول حديث هند من خلال فهم مقاصد الشريعة ومراعاة مصلحة المسلمين، وهو نفس النظر لحديث الإحياء مع التجرّد لمعرفة الحق، فحكمنا على الأول بالتشريع العام وعلى الثاني بتصرفات الإمامة الكبرى.
فإذن الفهم الصحيح والتدبر الحسن والتفقُّه في سُنة رسول الله ﷺ يؤدّي إلى تحصيل الضابط الذي به تعلم مراتب السُّنَّة النبوية.
(4)- النظر إلى أسباب التصرّفات النبوية: وهذا أمر يساعد على معرفة نوع التصرف ومرتبة السُّنَّة، فالتصرف بوصف القضاء أو الإمامة يظهر من خلال النظر الأوّلي بدون تدبر ابتداءً، على ضوء ما هو معروف من أعمال القضاء والإمامة الكبرى كما مرّ في سياق هذا المقال؛ ومن ذلك ارتباط منصب الإمامة بمصلحة العباد والبلاد لهذه القاعدة المعتبرة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، التي تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأماكن، في حين التشريع العام على حالة واحدة لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة، أما القضاء فالمعوّل عليه اتباع منهجه ﷺ فيه ووسائله وأصوله، وأشباههما، ولو تغيرّت النتائج.
ولذلك قال القرافي في «الفروق» (1/346):
«وكل ما تصرّف فيه ڠ بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدِم عليه إلّا بإذن الإمام اقتداء به ڠ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك.
وما تصرف فيه ﷺ بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم؛ اقتداء به ﷺ، ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه ﷺ بوصف القضاء يقتضي ذلك». اهـ.
ثم شرع في بيان صور تصرفات الإمام وتصرفت القاضي، على ما مرّ مُفَصّلًا، ثم قال:
«فهذه المواطن لا خفاء فيها، وأما مواضع الخفاء والتردد ففي بقية المسائل». اهـ.
فجعل تصرفات الإمام والقضاء ظاهرة بيّنة لا خفاء فيها، ثم بين أن التردد في مثل المسائل الثلاث التي ذكر فيها حديث الإحياء، وحديث هند، وحديث السلب، وقد بيّنت لك أنه عند التردد فالحكم بالتبليغ العام؛ لأنه الأصل، فلا يُصرف عنه إلّا بيقين، ولا يصرف بالشك، والقاعدة الكلية المتفق عليها: «اليقين لا يزول بالشك» واليقين هنا التبليغ والتشريع العام.
أما منصب القضاء، فالمراد هنا: ألا يعمم قضاء قضى به ﷺ بين خصمين لأسباب معينة إلا إذا وجدت هذه الأسباب أو شبهها، على حسب حكم الحاكم، وهذا أمر نسبيّ يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والبيّنات والحجاج، وقدرة الخصوم وضعفهم في إظهار براءتهم.
(*) التقعيد الأصولي في مسألة الباب:
فإذا أردنا أن نقعّد قاعدة في هذه المسألة المهمة التي تناولها هذا المقال، فأقول على ضوء ما تقدم بنص هذه القاعدة وهي:
«مراتب السُّنَّة النبوية ثلاث: التبليغ وهو التشريع العام، والإمامة الكبرى، والقضاء، والأصل المرتبة الأولى، وهي اليقين، فلا تُصرف عنها إلا بحجة وبرهان، فلا اعتبار للتردد لأنه شك واحتمال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والحكم للغالب، وغالب السُّنَّة التشريع العام لكل الناس، ولأن تصرفات الإمامة والقضاء معروفة محصورة، فلا تردد في اعتبارها ولا لبس فيُعتبرا وتُصْرف بهما المرتبة الأولى من التشريع العام إليهما على ضوء الدليل الصحيح الصريح، وضابط ذلك النظر إلى طبيعة التصرف ومعرفة سببه، مع الفهم الصحيح للأدلة، والإلمام بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، ولا تخرج السُّنَّة في مراتبها الثلاث عن صفتها من الأمرية أو الندبية أو التحريم والكراهة والإباحة، وإنما يحدث التقييد أو الشرطية لمنصب الإمامة الكبرى، كما في حديث الإحياء والسَّلّب، أو التخصيص لمنصب القضاء كما في حديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولا يحدث ذلك إلا بمستند شرعي وضابط ديني، وكل ما ظهر به العدل وحصلت به المصلحة فهو من شرع الله».
(*) تفريع على القاعدة فيما يختص بمنصب الإمامة والقضاء، أولًا: الإمامة:
(1) روى الترمذي في «سننه» (1314) وقال: حسن صحيح، وابن حبان في «صحيحه» (4935)، قال ابن حجر في «التلخيص» (ح1160): «وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان والترمذي»، من حديث أنس ﭬ قال:
غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله لو سَعّرت؟ فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المُسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله عزّ وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إيّاه في دم ولا مال».
قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص 231-232):
«وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضَوْنه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض فهو جائز، بل واجب أما القسم الأول: فمثل ما روى أنس: [فذكر الحديث] فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع عن بيعها، مع ضرورة الناس إليها إلّا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معني للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير هاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به» اهـ
فمع أن ظاهر الحديث المنع من التسعير، فإن النظر إلى مصلحة المسلمين بجلب مصالحهم ودفع مفاسدهم -وهو أصل من أصول التشريع المستنبط من عموم الكتاب والسُّنَّة- جعل ابن القيم $ يقسم التسعير إلى ما يجوز وما لا يجوز، وهذا ليس تغييرًا للسُّنة، بل هو حسن النظر فيها في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي قد استُخرجت من السُّنَّة نفسها، وهذا نظر فقهي أصولي متين لا يخالف النصوص، بل ولا هذا النص الخاص، لأنه ﷺ لم ينه عن التسعير في هذا الحديث بشكل جازم قطعي، بل جعل فيه متنفّسًا لمن يأتي بعده من الأئمة؛ لأن ظاهر الحديث أن الامتناع من التسعير تعلّق على خشية الظلم، فإن عُدم جاز التسعير، وهذا ما نظر إليه ابن القيم فجوّز صورًا من التسعير، ردًّا لجشع التجار وطمعهم.
وهذا أمر يختلف باختلاف أحوال الناس بين تقوى الله ومعصيته، وما يترتب على ذلك من تصرفات يقوم بها حكام المسلمين وأئمتهم بما يضبط النفوس ويردع المفسدين سلبًا وإيجابًا على حسب تغيّر الأحوال، والنصوص المستنبط منها التصرفات المتغيرة هي هي، فهذا منصب تصرفات الإمام، وقد مرّ مثل ذلك في حديث الإحياء والسَّلَب.
(*) ثانيًا: منصب القضاء:
وهذا تفريع على منصب القضاء: فقد روى مسلم في «صحيحه» (1712) عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد».
وروى البخاري في «صحيحه» (4552) ومسلم (1711) عن ابن عباس أيضًا أن النبي ﷺ قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعي عليه».
وزاد البيهقيّ في السنن الكبرى (5/332) (10/252) بسند صححه النووي في «شرح مسلم» (12/3) والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/308): «ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر».
وروى ابن ماجه في «سننه» (2038) بسند قال البوصيري في «الزوائد» (2/510): «هذا إسناد حسن رجاله ثقات» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ قال: «إذا ادّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استُحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» رواه ابن ماجه تحت باب «الرجل يجحد الطلاق» فهذا قضاء بشاهد ونكول المدعي عليه عن الحلف واليمين.
(*) وهناك القضاء بالقافة وهو قائم على اعتبار الشَّبَه، وقد اعتبره النبي ﷺ كما في حديث البخاري (130)، ومسلم (313)، وكذلك حديث مسلم (314)، (311) وحديث مجزز المدلجي في شأن زيد بن حارثة وابنه أسامة عند البخاري (3555) ومسلم (1459) وقد أقرَّ النبي ﷺ حكمه وفرح به.
وقال تعالى: ﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البقرة: 282].
وقال تعالى: ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [النساء: 135]، وهو حكم بالإقرار، وإقرار ماعز ﭬ في قصة زناه عند البخاري (6815) ومسلم (16/1691).
(*) وهناك القضاء بالقرعة كما جاء في حديث البخاري (2689) في الأذان والصف الأول والاستهام عليهما، وكذلك حديث عائشة ڤ عند البخاري (2688) قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج معها»، فهذه بعض طرق القضاء النبوي ذكرها ابن القيم في «الطرق الحكمية» وقد أوصلها إلى (26) طريقًا.
(*) وأمر القضاة بعده ﷺ ينظرون إلى هذه الطرق ويستخدموها في قضائهم، معتمدين عليها كأصول عامة نبويّة في فصل القضاء والخصومة بين الناس، يكون الاستنان فيها والاتباع اتباع منهج عام واستنانًا قائمًا على الفهم والفقه المتغير بتغير الأشخاص والأحوال والأزمان، يعني ليس بلازم أن يحكم في هذه المسألة بنفس ما حكم فيها رسول الله ﷺ ونفس طريقة القضاء، بل تتغير الطرق وتتغير نتائج التحقيق على حسب ما يراه القضاة تبعًا للحِجاج وحال الخصوم، ما دامت الغاية هي الوصول إلى العدل والإنصاف والحق، فالانتقال -مثلًا- من الحكم باليمين والشاهد، إلى طريقة أخرى ولتكن طريقة العلامات والقرائن فلا يضر، إذْ ما عُرفت براءة يوسف إلا بقرينة جذب قميصه من الدبر، وهذا أمر واسع يقوم على فطنة القاضي وذكائه وفراسته وما يراه مناسبًا للوصول إلى الحقيقة والعدل من خلال الطرق القضائية النبوية، أو ما يستجدّ في دنيا الناس من الوسائل والطرق الحديثة، كتتبع البصمات، وآثار الأقدام، وفصائل الدم، ومعرفة الأصوات، وكاميرات المرقبة كضرورة ملحّةّ لضبط المفسدين في الأرض وكفّهم عن الإفساد والإرهاب والتفجير.
فلا يقال: هذه طرق وسائل ما استعملها رسول الله فهي باطلة، بل كما قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص 27):
«فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استُخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له، فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات». اهـ.
فإذا كان كذلك فقد ظهر الفرق بين مراتب السُّنَّة النبوية الثلاث، وعُلم أن مرتبة الإمامة والقضاء من السنن للأئمة والقضاة من بعده ﷺ النظر إليهما نظر فهم وفقه وسعة أفق واستنباط واجتهاد قائم على جلب المصالح ودفع المفاسد للعباد والبلاد، نظر متحصن بمقاصد الشريعة، وقواعدها الكلية والإلمام بأدلة الأحكام، من خلالها يحدث الصرف والتقييد والشرط، لا بالهوى ولا التشهي ولا المصالح المزعومة الزائفة التي تخالف ظاهر النصوص الشرعية وروحها، ومن يرد الله به خيرًا يفقه في الدين، ومن أحسن فهم كتاب الله وسنة نبيّه ﷺ لا يحتاج إلى الابتداع، أو التحايل على الحرام، أو تغيير شرع الله.
روى ابن ماجه في «سننه» (43) واللفظ له، والترمذي في «سننه» (2676) وقال: حديث حسن صحيح، من حديث العرباض بن سارية عن رسول الله ﷺ قال:
«قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدًا حبشيًّا، فإن المؤمن كالجمل الأنِف، حيثما قِيد انقاد».
وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
وكـتـبَ :
د/ أَبو عبد الرحمن عِــيد بن أبي السـعـود الكــيال
للمزيد : تابع الموقع الرسمي للشـيخ
www.alkaial.com
([1]) رواه أحمد في «المسند» (14205)، والترمذي في «سننه» (1366) وحسّنه، وأبو داود في «سننه» (3074)، ورواه البخاري في «صحيحه» (2335) بلفظ: «من أعمر أرضًا ليس لأحد فهو أحق بها».
([2]) قلت: بل الراجح مذهب أبي حنيفة دفعًا لمفسدة الطمع والإيثار بالنفس الذي يولد الشقاق والخصومات بين الناس؛ لأن القاعدة: «دفع المفسدة مُقدم على جلب المصلحة»، وقد أدَّى عدم الإذن بالإحياء إلى القتال والقتل وإراقة الدماء في الكثير من المدن المصرية العشوائية.
([3]) رواه البخاري في «صحيحه» (2211)، ومسلم (1714) في «صحيحهما».
([4]) قلت: وهذا ما رجَّحه النووي وجزم به ونقله عن الرافعي، وأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة، وأن القصة كانت بمكة، وأكّده ابن حجر في شرح الحديث وبيّن أنه قول السهيلي [«فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9/566-567/حديث 5364)].
([5]) متفق عليه: البخاري (3142)، ومسلم (1751).
([6]) قلت: تقييد هذا الحديث بإذن ولي الأمر يضبط الأمور ويكبح جماح النفوس عن الطمع، ويقدم المصلحة العامة على الخاصة، ويثمر التنظيم وعدم الفوضى، وهذا أمر حسن مهم، والسلب ما كان مع المقتول من ثياب وسلاح وغير ذلك.
([7]) أراد: أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره، يقال: لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمه، ويخفى على غيره؛ لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم، إذْ أصل اللحن: الميل عن جهة الاستقامة (النهاية) لابن الأثير (4/208) «لحن».
([8]) يريد من ناحية اللفظ والسياق لا من ناحية أصل الأحكام، قال تعالى: ﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [النجم: 3-4]، كالفرق بين الحديث النبوي والقدسي.
([9]) متفق عليه: البخاري (3100)، ومسلم (1751).
([11]) متفق عليه: البخاري (5496)، ومسلم (1930).
([14]) رواه البخاري (233)، ومسلم (1761).
([15]) متفق عليه: البخاري (2697)، ومسلم (1778).
([16]) رواه أحمد في «المسند» (17270)، وأبو داود في «سننه» (3403)، وابن ماجه (2466)، والترمذي (1366) وقال: حسن غريب، وصححه المجد في «لمنتقى» (2432) بمجموع طرقه، والحديث ضعفه البخاري والخطابي والبيهقي للانقطاع بين عطاء ورافع بن خديج فلم يسمع منه، وحسنه المجد في «المنتقى» (2433)، وله طرق أخرى فحسّنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (846)، وانظر: «نيل الأوطار» (11/81-82).