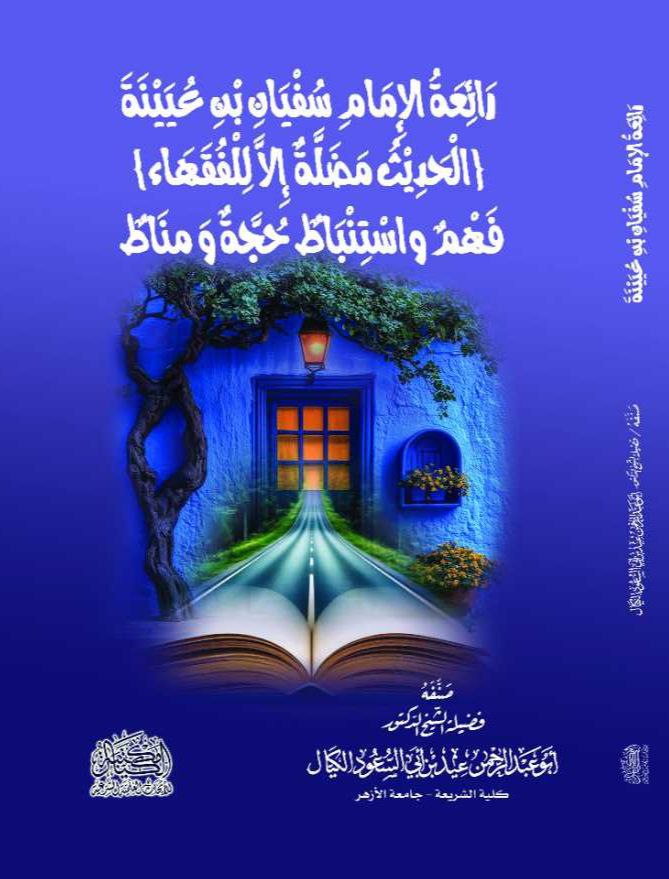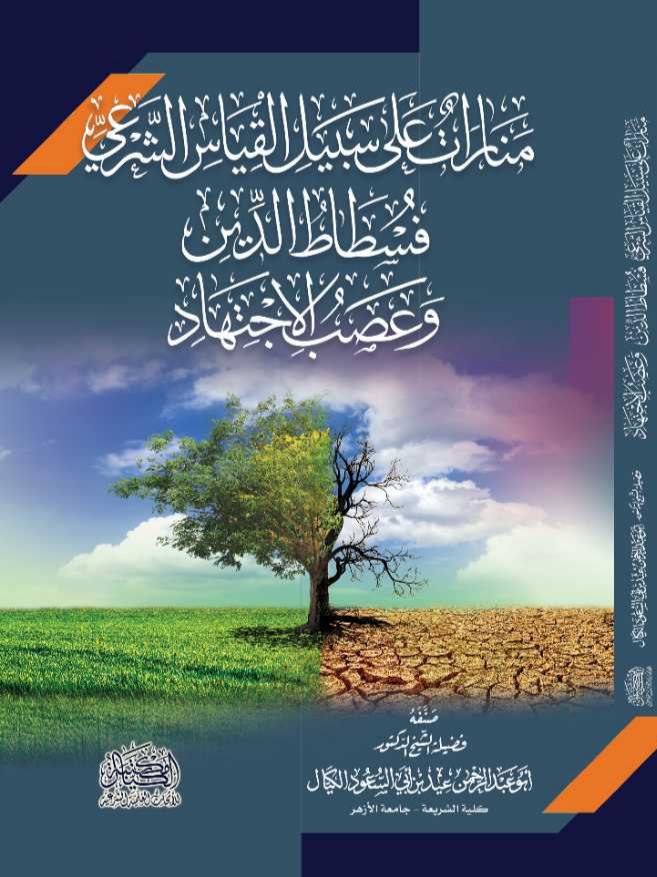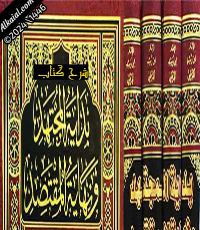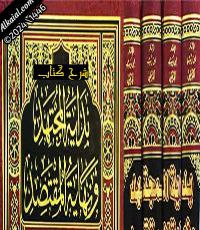«¢»
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ﷺ.
أمَّا بعد:
فلقد كتب الإمام الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري المشهور بالقرافيِّ (626- 684هـ) كتابه «الفروق أنوار البُرُوق في أنواء الفروق»، وهو كتاب كبير في أربعة مجلدات كبار -وقد قرأته أكثر من مرَّة- وهو كتاب جامع لجملة كبيرة من القواعد الشرعية الفقهية والأصولية والفرق بين هذه القواعد بفهم ووعي وإدراك وتصور متميز، وقد عُدَّ من أئمة الفقهاء والأصوليين في الإلمام بالمقاصد الشرعية كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والعز بن عبد السلام.
وفي هذه المقالة تكلمت على الفرق الحادي والثلاثين (1/327- 331)، وقد جمع بين أكثر من قاعدة من القواعد الأصولية وبيَّن فيها الفروق بين هذه القواعد، وأدْلى بدْلوه بما عنده من الملكة العلمية الأصولية المقصدية الاستنباطية القوية المنهجية.
ومن ثَمَّ أقمت مقالتي على هذا الفرق شرحًا له وتعليقًا، وبيانًا ما فيه من الفوائد الأصولية، وسأقُسّم كلامه إلى أجزاء حتى يُفهم المراد.
وأوَّل ما أبيّنه -تبعًا للسياق-: بيان معنى الكليِّ والكلّية والكل لارتباطه بالمراد.
وهذه ألفاظ يتداولها أهل المنطق بحدودهم وألفاظهم، ونحن نبيِّن ذلك بالكتاب والسنَّة على ما ذكره الأصوليون بعيدًا عن المنطق وأهله.
قال الله تعالى: ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الرحمن: 26]، وقوله: ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل عمران: 185]، وقوله ﷺ في «صحيح مسلم» (223): «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا».
فكلُ مِنْ أشد صيغ العموم وهو العموم الشامل، هذا هو معنى كل؛ إذْ كل نفس تموت، وكل نفس تفنى، وكل النَّاس يغدو، أي يسعى بنفسه إلى أسباب الجنَّة أو النَّار وقال تعالى: ﴿ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ﴾ [الحديد: 57]، ﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الحديد: 57]، ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [الملك: 67]، فهذا كله عموم تام،فهو بيان للمجموع الذي جَمَعَ جميع أفراده تحت مجموع الكل المذكور في الآيات والحديث، يعني أنَّ كل تفيد الاستغراق مثل جميع.
فلا يخرج فرد من أفراده عن هذا الشمول والعموم فردًا فردًا واستغراقًا تامًّا.
أمَّا المراد بالكلِّي:
فما رواه البخاري في «صحيحه» (1229)، ومسلم (99/573) من حديث ذي اليدين لما نسِيَ رسول الله ﷺ في الصلاة، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أنسيت أم قَصُرَتِ الصلاة؟ قال: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ» فقال ذو اليدين: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ.
قال الشوكاني في: «نيل الأوطار» (5/363/ ح1016):
«وتأييدٌ لما قال علماء المعاني: أنَّ لفظ «كل» إذا تقدَّم وعقبه النفي، كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخر، ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ.» اهـ.
وقال أيضًا الشوكاني في «إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول» (1/528- 529):
«وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على «كل»، وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدَّمت على حرف النفي، نحو: «كل القوم لم يَقُم» أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدَّم النفي عليها، مثل: «لم يقم كل القوم» لم يدلّ إلَّا على نفي المجموع، وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم.
ويسمَّى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم، من جهة أنَّ الأول يُحكم فيه بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يُفِدْ العموم في حق كل أحد؛ إِنَّما أفاد نفي الحكم عن بعضهم.
قال القرافي: وهذا شيءٌ اختصَّت به «كل» من بين سائر صيغ العموم، قال: وهذه القاعدة مُتّفقٌ عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله ﷺ: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ» لما قال له ذو اليدين: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ؟» اهـ.
قلت: وهذا هو الكليّ، وهو أخف من كلّ في عموم الشمول، لأنَّ كلَّ تُرد على الجميع، ولذلك أطلق على كل: عموم السلب وعلى الكليِّ سلبُ العموم.
قال الإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» (ص394 وما بعدها»:
«فأمَّا الكليِّ: أي: بالياء في آخره، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون، كالعلم والجهل والإنسان والحيوان، واللفظ الدال عليه يُسمّى مطلقًا، والجزئيِّ قسيمة كزيد وعمر.
وأمَّا الكل فهو المجموع من حيث هو مجموع، ومن ذلك أسماء الأعداد -كقوله: ﴿ﰏ ﰐ ﰑ﴾ [البقرة: 196]، فإذا ورد في النفي أو النهي صدق بالبعض؛ لأنَّ مدلول المجموع ينتفي به، ولا يلزم نفي جميع الأفراد ولا النهي عنها، فإذا قال: ليس له عندي عشرة، فقد يكون عنده تسعة، بخلاف الثبوت؛ فإنّه يدلُّ على الأفراد بالتضمّن، والجزء: بعض الشيء.
وأمَّا الكلية: فهي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى فرد، ويكون ثابتًا للكل بطريق الالتزام.
وتقابلها الجزئية: وهي الثبوت لبعض الأفراد، فإذا قال: «كل رجل ليشبعه زغيفان» غالبًا يصدق باعتبار الكلية دون الكل، أوْ «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» فبالعكس.
فإذا تقرر ذلك فنقول: دلالة العموم على أفراده كُلِّية، أي: تدلُّ على كل واحد دلالة تامة، ويعبر عنه بالكلي المجموعي» اهـ.
قلت: ومن ثَمَّ، فإنَّ كل والكلية بمعنًى واحد، والكل والكلي والكلية قد تفرعوا من كُلٍّ المذكورة في الكتاب والسّنة، وكان الكلي هو المطلق الذي عكس المقيد، وهو أيضًا سلب العموم، لا عموم السلب، كالإيمان المطلق ومطلق الإيمان.
(*) ثُمَّ أبدأ في كلام الفرافي: قال $ في «الفروق» (1/327- 328):
«الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكليِّ، وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية، وبينهما في الأمر والنهي والنفي»:
اعلم أنَّ العلماء أطلقوا في كتبهم حمل المطلق على المقيد، وجعلوا أنّ حمل المطلق على المقيد يفضي إلى العمل بالدليلين، دليل الإطلاق ودليل التقييد، وإنَّ عدم الحمل يفضي إلى إلغاء الدليل الدال على التقييد.
وليس الأمر كما قالوا على الإطلاق، بل هما قاعدتان متباينتان.
وبيان ذلك: أنَّ صاحب الشرع إذا قال: اعتقوا رقبة، ثُمَّ قال في موطن آخر: رقبة مؤمنة، فمدلول قوله رقبة كلِّي، وحقيقة مشترك فيها بين جميع الرقاب، وتَصْدُقُ بأي فرد وقع منها، فمن أعتق سعيدًا -أو زيدًا- فقد أعتق رقبة ووفى بمقتضى هذا اللفظ، فإذا أعتقنا رقبة مؤمنة فقد وفّينا بمقتضى الإطلاق، وهو مفهوم الرقبة، وبمقتضى التقييد وهو وصف الإيمان، فكُنَّا جامعين بين الدليلين وهذا كلام حق» اهـ.
قلت: ويلزم هنا معرفة المطلق والمقيد، قال الطوفي في: «شرح مختصر الروضة» (2/630):
«المطلق: ما تناول واحدًا غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو قوله: ﴿ﭞ ﭟ﴾ [المجادلة: 3]، وقوله ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» [رواه الترمذي (1101)، والحاكم في «المستدرك» (2717)، وصححه ووافقه الذهبي] فكل واحد من لفظ الرقبة والوليّ قد تناول واحدًا غير مُعَيَّن من جنس الرقاب والأولياء.
والمقيد: ما تناول مُعَيَّنًا نحو: اعتق زيدًا من العبيد، أوْ موصوفًا بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو: ﴿ﭲ ﭳ﴾ [النساء: 92]، ﴿ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [النساء: 92]، وَصَفَ الرقبة بالإيمان والشهرين بالتتابع، وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين؛ لأنَّ الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة، والشهرين قد يكونان متتابِعَيْن وغير متتابعين … وقال الآمدي: المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، كقولنا: رجل، والمقيد: ما كان من الألفاظ دالًّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولنا: رجل عالم» اهـ.
ثُمَّ قال القرافي في «الفروق» (2/327- 328):
«أمَّا إذا ورد أمر الشرع بإخراج الزكاة مِنْ كُلّ أربعين شاة شاة [رواه البخاري: (1454)] كما جاء في الحديث، ثُمَّ ورد بعد ذلك قوله ڠ: «في الغنم السائمة الزكاة» [رواه البخاري (1454)] فمن قصد في هذا المقام حمل المطلق الأول على المقيد الذي هو الغنم السائمة؛ اعتمادًا منه على أنَّه من باب حمل المطلق على المقيد فقد فاته الصواب؛ بسبب أن الحمل هنا يوجب أنَّ المقيد خَصَّص المطلق وأخرج منه جميع الأغنام المعلوفة، والعموم يقتضي وجوب الزكاة فيها، فليس جامعًا بين الدليلين، بل تاركًا لمقتضى العموم وحاملًا له على التخصيص مع إمكان عدم التخصيص، فلا يكون الدليل الدال على حمل المطلق على المقيد موجودًا هاهنا وهو الجمع بين دليل الإطلاق ودليل التقييد، ومن أثبت الحكم بدون موجِبِه ودليله فقد أخطأ، بل هذا يرجع إلى قاعدة أخرى وهي تخصيص العموم بذكر بعضه» اهـ.
قلت: أمَّا القاعدة الأخرى المذكورة فهي ما نصَّ عليها الأصوليون: «ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا»، وفي لفظ: «الموافق للعام لا يُخصّص».
وفرع هذه القاعدة التي تُبيّن معناها: ما رواه البخاري (580)، ومسلم (607) من حديث أبي هريرة ﭬ عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ»، فهذا عام في الصلوات الخمس فلا تختص به صلاة من الصلوات؛ لأنَّ ذكر بعض أفراد العام -وهو أي صلاة من الخمس- لا يعتبر تخصيصًا، لأنَّ أي صلاة تدخل في العموم فلا تخصيص هنا.
فقد روى البخاري (579)، ومسلم (608) قال ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»، فهنا لا يعتبر ذكر الفجر والعصر تخصيصًا لأنهما بعض الصلوات الخمس، وهذا مقرر عن أهل الأصول والقاعدة ثابتة عندهم وكذلك ما رواه البخاري (335)، ومسلم (522) من حديث حذيفة ﭬ عن رسول الله ﷺ قال: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، وهذا عام في التيمم من كل الأرض، من التراب والرمال وغير ذلك من أنحاء الأرض، فإذا أتى دليل بلفظ منها فهو بعض أفراد العام فلا يخصّص به العموم كما في رواية مسلم (4/522): «وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا».
قال النووي في «شرح مسلم» (3/5) عند الحديث:
«احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة -رحمهما الله تعالى- وغيرهما ممَّن يجيز التيمم بجميع أجزاء الأرض، واحتج بالثانية الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- وغيرهما ممَّن لا يُجَوِّز إلَّا التراب خاصة، وحملوا المطلق على المقيد» اهـ.
قلت: وعلى وفق هذه القاعدة الأصولية أنَّ الراجح عموم الأرض الذي هو الصعيد فالقول قول مالك وأبي حنيفة.
وقول القرافي آنفًا: «والعموم يقتضي وجوب الزكاة فيها، فليس جامعًا بين الدليلين بل تاركًا لمقتضى العموم وحملًا له على التخصيص مع إمكان عدم التخصيص، فلا يكون الدليل الدال على حمل المطلق على المقيد موجودًا هنا، وهو الجمع بين دليل الإطلاق ودليل التقييد» اهـ.
ومراد القرافي هنا: أنَّ العموم لابدَّ أن يكون على عمومه في الغنم السائمة والغنم المعلوفة لعموم الدليل الذي لا ينبغي أن يخصّص هنا؛ لأنه هنا ليس من باب العموم والخصوص، بل هو من باب قاعدة «ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا» فأراد أن يقول: المَحْمَلُ الصحيح هنا على هذه القاعدة، ففرّق بين القواعد ودلالتها وحسن الفهم والاستنباط وتعيين القاعدة التي تصلح هنا، ممَّا لا تصلح، وهذا هو المنهج الأصولي السديد في دقّة الفهم وحسن الاستنباط المتفرع عليه صلاحية الفتوى المعتبرة.
(*) ثُمَّ قال القرافي في «الفروق» (1/328):
«والصحيح عند العلماء أنه باطل، لأنَّ البعض لا ينافي الكل، أو من قاعدة «تخصيص العموم بالمفهوم الحاصل بقيد السَّوم وفيه خلاف» اهـ.
قلت: قوله: «لأنَّ البعض لا ينافي الكل» هو يؤكد على صحة القاعدة المذكورة: «ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا»؛ لأنَّ البعض موافق الكل الذي هو العموم، فلا تخصيص في المسألة.
ثُمَّ انتقل إلى قاعدة المفهوم وادَّعى أنَّ فيها خلافًا، وهو مفهوم المخالفة.
فحديث البخاري (1454): «في الغنم السائمة زكاة» معناه: أنَّ الزكاة المفروضة في الغنم هي الغنم السائمة التي تُعْلَف من الكلأ المباح الذي لا يُنفق عليها بالمال، أمَّا الغنم المعلوفة بالإنفاق فلا زكاة فيه، فمفهوم المخالفة كان باختلاف الصفة في الغنم من السائمة إلى المعلوفة.
قال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه» (4/13):
«مفهوم المخالفة وهو: إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، ويُسمى دليل الخطاب وقال القرافي في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد([1]) الحكم المنطوق به أو نقيضه؟ الحق: الثاني، ومن تأمَّل المخالفات وجدها كذلك وقوله تعالى: ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [التوبة: 84] إذ مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المؤمنين» اهـ.
وقال السمعاني في «قواطع الأدلة في الأصول» (1/237- 238):
«واعلم أنَّ حقيقة دليل الخطاب: أن يكون المنصوص عليه صفتان، فيُعلّق الحكم بإحدى الصفتين، وإن شئت فقلت: فيقيد الحكم بإحدى الصفتين، فيكون نصّه مثبتًا للحكم مع وجود الصفة، فدليله نافيًا للحكم مع عدم الصفة، كقوله ﷺ: «في الغنم السائمة الزكاة» فنصّه: وجوب الزكاة في السائمة، ودليله: نفي وجوب الزكاة في المعلوفة، ودليله: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [الحجرات: 6]، فنصه: مقتضى التَّثبّت في قول الفاسق، ودليله: قبول قول العدل وترك التثبّت فيه» اهـ.
ثُمَّ قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (1/242):
«وفي هذا إجماع من الصحابة على القول بدليل الخطاب» اهـ.
وقد فصلت القول في مفهوم المخالفة في كتابي: «ما قلَّ ودلَّ في أصول الفقه للمستدل» في الجزء الثالث: (3/1214/ وما بعدها)، وفي بيان الدليل عليها من الكتاب والسنَّة والإجماع.
وعليه، فإنَّ وجود الإجماع يُنافي وجود الخلاف في مفهوم المخالفة وزعم القرافي الخلاف.
(*) ثُمَّ قال القرافي في «الفروق» (1/328):
«أمَّا أنه من باب حمل المطلق على المقيد فلا؛ لأنه كليةٌ ولفظٌ عامٌ، وإِنَّما يستقيم حمل المطلق على المقيد في الكليِّ المطلق لا في الكلية لما تقدم من الفرق» اهـ.
قلت: يعني أنَّ المطلق كليِّ، والكليةُ: وهي ثبوت الحكم لكل واحد -كما مرَّ في المقدمة- ولفظ عام: أراد أنه لابدَّ أن يكون على عمومه ولا يخصص إلَّا بدليل، لأنه إِنَّما يستقيم حمل المطلق على المقيد في الكليِّ المطلق لا في الكلية التي تكون في العام كقوله تعالى في العموم الشامل: ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل عمران: 185]، فلا خصوص لعموم هذه الآية، وكذلك هنا، أمَّا الكلي فهو المطلق الذي ليس فيه العموم الشامل، لأنَّ الكليِّ فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون وليس هو العموم المستغرق لكل أفراده، ففرق كبير بين المطلق والعام وبين الكلي والكلية.
ثُمَّ انتقل القرافي إلى مسألة أخرى فقال $ في «الفروق» (1/328):
«وكذلك وقع في كتب العلماء التسوية بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد، وليس كذلك فإنَّ صاحب الشرع لو قال: لا تعتقوا رقبة، ثُمَّ قال: لا تعتقوا رقبة كافرة، كان اللفظ الأول من صيغ العموم، لأنَّ النكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي تعُم، فيكون اللفظ الثاني لو حملنا الأول عليه مُخصصًا للأوَّل فإنه يخرج الرقاب المؤمنة عن امتناع العتق والعموم يتقاضاه، فلم يكن فيه جمع بين الدليلين، بل التزام للتخصيص بغير دليل وإلغاء للعموم من غير موجب، بخلاف هذه النكرة لو كانت في سياق الأمر فإنها حينئذ لا تكون عامة بل مطلقة، فيكون حملها على نص التقيد جمعًا بين الدليلين، فظهر أيضًا الفرق بين الأمر والنهي» اهـ.
(*) قال الزركشي في «البحر المحيط» (2/430):
«والنهي المطلق يقتضي التكرار والدوام، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن بَرْهان وأبو زيد في «التقويم».
وقال الماوردي: «حكى غير واحد الاتفاق على أنَّ النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمر» اهـ.
قلت: تكلم أهل الأصول في مسألة الفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد فجعلوه في الأمر ولم يجعلوه في النهي.
ذكر القرطبي أبو العباس في «المفهم لما أُشْكِل من تلخيص كتاب مسلم» (3/354/ح1195) حديث البخاري (7288)، ومسلم (2357) قال ﷺ: «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
ثُمَّ قال: «يعني: أنَّ النَّهي على نقيض الأمر، وذلك أنه لا يكون ممتثلًا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله، ومن فعل واحدًا فقد خالف وعصى، فليس في النهي إلَّا ترك ما نُهي عنه مطلقًا دائمًا، وحينئذ يكون ممتثلًا ما أُمر به بتركه بخلاف الأمر» اهـ.
قلت: وهذا كلام منضبط مستقيم على الأصول؛ لعموم هذا الحديث وظهور دلالته، والفرق بين حمل المطلق على المفيد في الأمر دون النهي؛ لذلك قال القرطبيِّ:
«فليس في النَّهي إلَّا ترك ما نُهي عنه مطلقًا أبدًّا»؛ يعني: ليس فيه تقييد لأنه يُخرج بعض أفراده فيكون غير مستغرق ولا شامل وهذا لا يستقيم.
وقال الزركشي في «البحر المحيط» (3/430):
«أن يكون في باب الأوامر والإثبات، وأمَّا في جانب النهي والنفي فلا، لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي، وهو غير سائغ، ذكره الآمدي وابن الحاجب وقالا: لا خلاف -أي: في المذهب- بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر، فإذا قال: لا تعتق مُكاتبًا، لا تعتق مُكاتبًا كافرًا، لم يعتق مكاتبًا كافرًا ولا مؤمنًا أيضًا؛ إذ لو أعتقه لم يعمل بالنصَّين» اهـ.
وكذلك قال ابن دقيق العيد في كتابه: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص106- 107) ح(15) الذي رواه البخاري (154)، ومسلم (267): أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يَمَسَّن أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ»، وفي رواية: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ».
ثُمَّ قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث:
«الحديث يقتضي النهي عن مسّ الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مس الذكر مطلقًا من غير تقييد بحالة البول، فمن النَّاس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد سبق إلى الفهم: أنَّ المطلق يُحمل على المقيد فيختصّ النهي بهذه الحالة، وفيه بحث؛ لأنَّ هذا الذي يُقال يتّجه في باب الأمر والإثبات، فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلًا: كان فيه إخلال باللفظ الدال على التقييد وقد تناوله الأمر، وذلك غير جائز، وأمَّا في باب النهي فإنَّا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غير سائغ» اهـ.
قلت: فإذن لا يحمل المطلق على المقيد في النهي والنفي كما قرره القرافي.
(*) ثُمَّ قال القرافي «الفروق» (1/328- 329):
«والإمام فخر الدين في «المحصول»، وغيره من العلماء، نصَّ على التسوية بينهما وليسا بمستويين فتأمل ذلك كما بيّنته لك؛ فيتحصّل من هذا البحث أنَّ حمل المطلق على المقيد إنَّما يتصور في كُلِّي دون كلية، وفي مطلق دون عموم، وفي الأمر وخبر الثبوت دون النهي وخبر النفي؛ لأنَّ خبر النفي كقولنا: ليس في الدار أحد، يقع نكرة في سياق النفي فيعم، فيؤول الحال إلى الكلية دون الكلي، وخبر الثبوت هو كالأمر نحو: في الدار رجل، فإنه مطلق كلِّي لا كلية؛ لأنَّ النكرة لا تعم في سياق الثبوت» اهـ.
قلت: ومن جملة البيان في هذا السياق التفريق بين المطلق والعام، وقد ظهر من هذه المقالة ما يشير إلى ذلك، ولكن بدون تمييز وتفصيل، ولذلك زِدْتُهُ على كلام القرافي هنا.
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (1/516- 517):
«المسألة الرابعة في الفرق بين العام والمطلق: اعلم أنَّ العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، وبهذا يتضح الفرق بينهما، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ موارده غير منحصرة، فصح إطلاق اسم العموم عليه من هذه الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل: أنَّ عموم الشمول كلٌ، يُحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كُلٌ من حيث إنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يُحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فردٍ شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر منها دفعة» اهـ.
قلت: المراد بدفعة: واحدة، أي أنَّ العام يشمل أفراده دفعة واحدة في آنٍ واحد، فظهر من كلام الشوكاني أنَّ المطلق هو الكُلِّيُّ وأنَّ عموم المطلق بدلي، يعني قوله تعالى: ﴿ﭱ ﭲ﴾ [المجادلة: 3] تحرير أيِّ رقبة؛ أي: أعتق بكرًا أو زيدًا أو عليًّا أو …. أو…..، فكل رقبة بديل للأخرى فهو بدلي يقوم أحدها مقام الآخر، لذلك فهو كلي فلا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل هو شائع في جميع أفراد يتناولها على سبيل البدل.
لذلك يقولون على الكلي الذي هو المطلق هنا: مالا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه.
أمَّا عموم الشمول في الكُلّ الذي لا يتخلف من أفراده فرد واحد، بل يحكم فيه على كل فردٍ فردٍ، كعموم الشمول في قوله تعالى: ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [القصص: 88]، فكل فردٍ فردٍ من العموم والشمول فإنه هالك ميت، كما قال تعالى: ﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [الزمر: 30]، ويطلق كلّ أيضًا على الكلَّية كما مرَّ في بداية المقالة.
وزاد الشيخ محمد صالح العثيمين $ فقال في «شرح الأصول من علم الأصول» (ص: 320- 321):
«التمييز بين العام والمطلق يحصل بالتعريف، وسبق لنا أنَّ العام: هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، أمَّا المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وإنَّما يخص فردًا منها، لكنه غير معيّن، ولهذا يُقال: العام شموله عمومي وإن شئت قلت: عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، فهذا هو الفرق.
وهناك فرق آخر: العام يدخله التخصيص -يعني: الاستثناء- والمطلق: لا يدخله الاستثناء، مثال ذلك: قلتُ لك: أكْرِم الطالب، فقولي: الطالب عام يشمل جميع الطلبة، لأنَّ أكْرِم الطالب أي: أكْرِم كلّ طالب فـ «أل» هنا للعموم، وإذا قلتُ: أكرم طالبًا، فهذا مطلق؛ لأنه لو كان عندنا الآن عشرة طلاب وقلت: أكرم طالبًا فلا يلزم أن أعطي كل واحد من العشرة.
ثانيًا: العام لا يصح الاستثناء منه، قال تعالى: ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ﴾ [العصر: 2، 3]، والمطلق لا يصح الاستثناء منه؛ لأنه لا يعم إلَّا واحدًا، والواحد كيف يستثنى منه؟!» اهـ.
(*) ثُمَّ ختم القرافي هذا الفرق من فُروقه بجملة من الفروع الفقهية المهمة؛ حتى تكتمل الفائدة والمعلومة فقال في «الفروق» (1/329- 331):
«وإذا تقرر الفرق واتضح الحق فهاهنا أربع مسائل:
المسألة الأولى: الحنفية لا يرون حمل المطلق على المقيد خلافًا للشافعية، وكان صدر الدين الحنفي يقول: إنَّ الشافعية تركوا أصلهم لا لِمُوجِبٍ فيما ورد عن رسول الله ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وورد «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [رواه البخاري (172)، ومسلم (279)] فقوله ﷺ: «إِحْدَاهُنَّ» مطلق، وقوله ﷺ: «أُولَاهُنَّ»، مُقيد بكونه أوَّلا، ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعيّنوا الأولى بل أبقوا الإطلاق على إطلاقه، وكان يُورد هذا السؤال على فضلاء الشافعية فيعسُر عليهم الجواب عنه، فسمعته يومًا يورده فقلت له: هذا لا يلزمهم لأجل قاعدة أصولية مذكورة في هذا الباب، وهي أنَّا إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فورد المطلق مقيّدًا بقيدين متضادّين، فتعذّر الجمع بينهما تساقطًا، فإنْ اقتضى القياس الحمل على أحدهما نُرَجّح، وفي هذا الحديث ورد المطلق فيه مُقيَّدًا بقيدين متضادين فورد «أُولَاهُنَّ» وورد «أُخْرَاهُنَّ» وهما متضادَّان فتساقطا.
وبقي إحداهن على إطلاقه فلم يخالف الشافعية أصولهم، وأمَّا أصحابنا المالكية فلم يعرّجوا على هذا الحديث المطلق ولا على قَيْدَتْه، بل اقتصروا على سبع من غير تراب، وأنا متعَجّب من ذلك مع وروده في الأحاديث الصحيحة» اهـ.
قلت: في هذه الأحاديث رواية أخرى بلفظ «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم (93/280) في «صحيحه».
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/212- 214) ح(19، 20):
«وقوله: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» أصح من رواية «إِحْدَاهُنَّ» قال في البدر المُنِير: «بإجماعهم»، وقال ابن منده: (إسناد مُجْمَعٌ على صحته»، وهي زيادة ثقة فتعيّن المصير إليها، وقد ألزم الطحاوي -الحنفي- الشافعية، واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية، فقد وقف على صحته غيره، لاسيما مع وصيّة الشافعي بأنَّ الحديث إذا صح مذهبه، فتعين حمل المطلق على المقيّد… ومقتضى حمل المطلق على المُقيّد أن تُحْمَل المُبْهمة على إحدى المرات المعينة، ورواية «أُولَاهُنَّ» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأنَّ تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نصَّ الشافعي على أنَّ الأُولى أوْلَى كذا في «الفتح»» اهـ يعني «فتح الباري» لابن حجر (1/276) عند الحديث.
(*) ثُمَّ ذكر القرافي في المسألة الثانية حديث مسلم (1529) قال ﷺ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» وفي رواية لمسلم (1528): «حتى تكتاله» وفي رواية «حَتَّى تَقْبِضَهُ» عند البخاري (2137)، ومسلم (1526).
والحديث الثاني رواه الترمذي في «سننه» (1234)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في «سننه» (2188) أنه ﷺ «نهى عن بيع ما لم يضمن» وفي رواية: «لا يَحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرْطَان في بيع، ولا ربح ما لم يضْمنْ» وصححه الحاكم في «المستدرك» (2185)، ووافقه الذهبي.
فقال القرافي:
«ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن بيع ما لم يُضمن»، وأخذ الشافعي بعموم هذا الحديث.
وورد أيضًا نهيه ڠ: «عن بيع الطعام قبل قبضه» فخصص أصحابنا المالكية المنع بالطعام خاصة، وجوَّزوا بيع غيره قبل قبضه.
واختلف مداركهم في ذلك -يعني: أدلتهم ومسالكهم- فمنهم من يقول: هو من باب حمل المطلق على المقيد، فيحمل الإطلاق في الحديث الأول على التقييد في الحديث الثاني ومنهم من يقول: الأول عام والثاني خاص، وإذا تعارض العام مع الخاص قُدِّم الخاص على العام، والمدركان باطلان؛ أمَّا الأول فلأنه -وقد تقدم- أنَّ المطلق إنَّما يُحمل على المقيد في الكليِّ دون الكلية، وهذا الحديث الأول عام فهو كلية، فلا يصح فيه حمل المطلق على المقيد، وأمَّا المَدْرَك الثاني فهو من باب تخصيص العموم بذكر بعضه، والطعام هو بعض ما تناوله العموم الأوّل فلا يصح تخصيصه به، فبقيت المسألة مشكلة علينا، ويظهر أنَّ الصواب مع الشافعي» اهـ.
قلت: وقول الشافعي على العموم والعام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه؛ وذلك لأنَّ لفظ الحديث عموم شمولي فهو كلية تستغرق جميع الأفراد وهذه الكلية تشمل ثبوت الحكم لكل واحد، وذلك للمعنى المراد من هذا العموم، وهو أنه نهى عن بيع ما لم يُضمن كان البيع طعامًا أو غيره، فلا خصوصية هنا لفرد من أفراد العام، فيدخل هذا الحديث في القاعدة السابقة: «ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا»، وهذا بالنسبة للمَدْرَك الثاني، أمَّا المدرك الأول فالخطأ في التشخيص الأصولي، فإنه ليس من باب حمل المطلق على المقيد، لأنه عام وليس بمطلق، لأنَّ المطلق يُحمل على المقيد في الكلي الذي هو المطلق، لا في الكلية التي هي العام.
ولذلك كنت دائمًا أذكر هذه القاعدة الأصولية العقلية الفهمية: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» فلن يستقيم لك فهم المسائل حتى تتصور وتدرك وتفهم وتعي سياق المسألة المطروحة وتستوعبها ومرادها الصحيح، ثُمَّ تأخذ المدرك والحجة والدليل والبرهان المناسب في محلّه، وإلَّا لاختلطت عليك الأدلة والمدارك والقواعد ويفسد استنباطك واستدلالك، وهذا ما أراد الإمام القرافي بيانه في «الفرق» من فروقه؛ ليصح لك التوجه المستقيم في تناول الموضوعات التي تريد توجيهها المناسب لها، فاعلم ذلك فإنه قوي متين عزيز الفهم والإدراك.
(*) ثُمَّ قال القرافي:
«المسألة الثالثة: قال مالك $: ومن ارتدّ حبط عمله بمجرد ردّته، وقال الشافعي $: لا يُحبط عمله إلَّا بالوفاة على الكفر؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر: 65]، وإن كان مطلقًا وتمَسك به مالك على إطلاقه، غير أنه قد ورد مقيدًا في الآية الأخرى: ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [البقرة: 217] فيجب حمل المطلق على المقيّد فلا يُحْبَط العمل إلَّا بالوفاة على الكفر.
والجواب: أنَّ الآية الثانية ليست مقيدة للآية الأولى؛ لأنها رُتّب فيها مشروطان، وهما الحبوط والخلود على شرطين وهما: الردّة والوفاة عليها، وإذا رُتّب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع؛ فيكون الحبوط المطلق الردة، والخلود لأجل الوفاة على الكفر، فيبقى المطلق على إطلاقه، ولم يتعَيَّن أن كل واحد من الشرطين شرط في الإحباط، فليست هاتان الآيتان من باب حمل المطلق على المقيد، فتأمل ذلك فهو من أحسن المباحث سُؤالًا وجوابًا» اهـ.
قلت: قال ابن الشاط المالكي الذي علَّق على كتاب «الفروق» (1/194) بهامش الكتاب قال:
«قلت: ليس هذا الجواب عند بصحيح؛ وقوله: «إذا رتب مشروطان على شرطين، أمكن التوزيع، صحيح، لكن يُشترط أن يصح استقلال كل واحد من المشروطين عن الآخر، أمَّا إذا لم يصح الاستقلال فلا؛ والمشروطان ممَّا فيه الكلام من الضرب الثاني الذي لا يصح فيه استقلال أحد المشروطين عن الآخر؛ لأنهّما سبب ومسَبَّب، والسبب لا يستغنى عن مسَبَّبه وبالعكس، فالأمر في جوابه ليس كما زعم، والله تعالى أعلم» اهـ.
قلت: قال أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن» (1/147- 148):
«اختلف العلماء -رحمة الله عليهم- في المُرتدّ، هل يُحْبِط عمَلَه نفسُ الردّة أم لا يُحْبَط إلَّا على الموافاة على الكفر؟
فقال الشافعي: لا يُحْبَطُ له عمل إلَّا بالموافاة كافِرًا، وقال مالك يُحبط بنفس الردة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجّ ثُمَّ أسلم، فقال مالك: يلزمه الحجّ؛ لأنَّ الأول قد أُحْبِط بالردّة، وقال الشافعي: لا إعادة عليه لأنَّ عمله باق.
واستظهر علماؤنا بقول الله تعالى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر: 65]، وقالوا: هو خطاب للنَّبِيّ ﷺ، والمراد به أمّته؛ لأنه ﷺ يستحيل منه الردة شرعًا.
وقال علماؤنا: إنمَّا ذكر الموافاة شرطًا هاهنا؛ لأنه علَّق الخُلود في النار جزاءً، فمن وافى كافرًا خلده الله في النَّار بهذه الآية، ومن أشْرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين» اهـ.
قلت: وما قاله القرافي هو نفس كلام ابن العربي؛ لأنه جعلهما معنيين وحكمين منفصلين مختلفين.
(*) ثُمَّ ختم القرافي كلامه في هذا الفرع والمسألة الرابعة بما ذكرته من قبل في سياق آخر، وهو عدم حمل المطلق على المقيد في حديث «الصحيحين»: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» لأنه من باب قاعدة «ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصًا» فلا يُحمل قوله في رواية مسلم «تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا» لأنَّ التراب فرد من أفراد العام وهو الأرض، فقال القرافي:
«قال الشافعي: هذا من باب حمل المطلق على المقيد فيحمل الأول على الثاني، فلا يجوز التيمم بغير التراب، وهذا لا يصح؛ فإنَّ الأول عام كلية لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد، لما تقدم أنَّ ذلك لا يصح إلَّا في الكلي دون الكلية» اهـ.
يعني: في المطلق دون العام.
هذا آخر ما كان من كلام الإمام الفقيه الأصولي البارع من جملة من الفوائد المتميّزة، وما كان منها من الشرح والتفصيل والتأصيل الأصولي والبيان، فمن قرأها فليتدبّرها جيِّدًا وبلا عجلة، لأنَّ فيها خيرًا كثيرًا، ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوسف: 76].
والحمد لله أولًّا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
كتبه
الباحث الشرعي الدكتور
عيد بن أبي السعود الكيال
دكتوراه من كلية الشريعة
جامعة الأزهر بالقاهرة
([1]) الضد: كالعدم والوجود، لا يجتمعان، والنقيض، ومثله: الأمر والنهي نقيضان، وقيل: وجود الحكم بلا علَّة. «التعريفات» (ص121، 219).